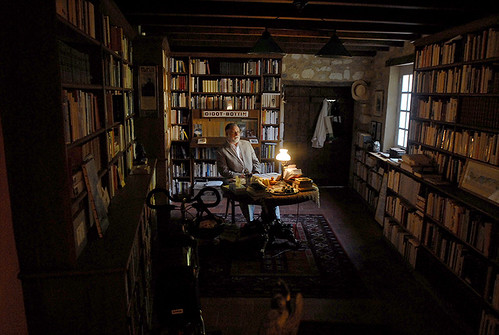تُصوّر هذه اللوحة المصير البائس الذي انتهى إليه قابيل، الابن الأكبر لآدم وحوّاء، والذي بعد أن قتل شقيقه الأصغر هابيل، حُكم عليه بالتيه الدائم.
قابيل المنهك والسائر على غير هُدى يظهر في أقصى يمين الصورة وهو يقود قبيلته عبر الصحراء استباقا لغضب الربّ. وعلى محفّة خشبيّة يحملها أبناؤه، تجلس امرأة حائرة مع طفليها النائمين. بينما تظهر حيوانات وقطع من لحم نازف وهي معلقّة على طرف المحفّة.
الرجال الآخرون، وبينهم صيّادون، يمشون جنبا إلى جنب. الخوف من غضب الربّ مرتسم على الوجوه. أحد الأشخاص يحمل بين ذراعيه امرأة شابّة يبدو على ملامحها الإنهاك والمرض، بينما تظهر بعض الكلاب الضالّة في الخلف.
الرسّام الفرنسي فرناند كورمون جعل الظلال طويلة كما لو أن ضوء الحقيقة يلاحق المذنب في هذا السهل المجدب والكئيب. وقد استخدم الألوان الترابيّة وضربات الفرشاة القويّة كي يضيف توتّرا إلى الصورة. كما انه ركّز على دقّة التشريح بأن جلب إلى محترفه أشخاصا حقيقيين لتمثيل كلّ شخصيّة.
هذه اللوحة تمثل إعادة بناء انثروبولوجية للقصّة المشهورة التي وردت في العديد من الكتب السماوية. كما أنها تقدّم ميدانا جديدا، أي عصور ما قبل التاريخ، وبالتحديد الوقت الذي بدأ فيه الإنسان بالرسم على الصخور في العصر الحجريّ القديم.
وفي غياب أيّة وثائق أو أسانيد مؤكّدة، خمّن الرسّام طبيعة الحياة في تلك الأزمنة البعيدة، عندما كان البشر البدائيّون يكافحون من أجل البقاء ويتنقّلون بأقدام حافية وشعر مجعّد وجلد خشن. وقد اختار الرسّام عنوانا فرعيّا للوحة اقتبسه من استهلال قصيدة لـ فيكتور هوغو بعنوان "الضمير" يقول فيه: عندما فرّ قابيل من غضب ربّه أشعث الشعر مغبرّا كان يصحبه أبناؤه. كانوا يرتدون جلود الحيوانات وتتقاذفهم العواصف. وعندما تلاشى الضوء، وصل الرجل الكالح إلى سفح جبل في سهل واسع".
تقول القصّة إن قابيل، بعد ارتكابه جريمة قتل شقيقه، رحل وهو وزوجته عن منزل والديه ليعيشا في مكان بعيد. وقد أنجبا في ذلك المكان أطفالا. ثمّ أسّس أبناؤه في ما بعد مدينة أطلق عليها قابيل هانوك أو إدريس، على اسم طفله الأوّل.
قابيل المنهك والسائر على غير هُدى يظهر في أقصى يمين الصورة وهو يقود قبيلته عبر الصحراء استباقا لغضب الربّ. وعلى محفّة خشبيّة يحملها أبناؤه، تجلس امرأة حائرة مع طفليها النائمين. بينما تظهر حيوانات وقطع من لحم نازف وهي معلقّة على طرف المحفّة.
الرجال الآخرون، وبينهم صيّادون، يمشون جنبا إلى جنب. الخوف من غضب الربّ مرتسم على الوجوه. أحد الأشخاص يحمل بين ذراعيه امرأة شابّة يبدو على ملامحها الإنهاك والمرض، بينما تظهر بعض الكلاب الضالّة في الخلف.
الرسّام الفرنسي فرناند كورمون جعل الظلال طويلة كما لو أن ضوء الحقيقة يلاحق المذنب في هذا السهل المجدب والكئيب. وقد استخدم الألوان الترابيّة وضربات الفرشاة القويّة كي يضيف توتّرا إلى الصورة. كما انه ركّز على دقّة التشريح بأن جلب إلى محترفه أشخاصا حقيقيين لتمثيل كلّ شخصيّة.
هذه اللوحة تمثل إعادة بناء انثروبولوجية للقصّة المشهورة التي وردت في العديد من الكتب السماوية. كما أنها تقدّم ميدانا جديدا، أي عصور ما قبل التاريخ، وبالتحديد الوقت الذي بدأ فيه الإنسان بالرسم على الصخور في العصر الحجريّ القديم.
وفي غياب أيّة وثائق أو أسانيد مؤكّدة، خمّن الرسّام طبيعة الحياة في تلك الأزمنة البعيدة، عندما كان البشر البدائيّون يكافحون من أجل البقاء ويتنقّلون بأقدام حافية وشعر مجعّد وجلد خشن. وقد اختار الرسّام عنوانا فرعيّا للوحة اقتبسه من استهلال قصيدة لـ فيكتور هوغو بعنوان "الضمير" يقول فيه: عندما فرّ قابيل من غضب ربّه أشعث الشعر مغبرّا كان يصحبه أبناؤه. كانوا يرتدون جلود الحيوانات وتتقاذفهم العواصف. وعندما تلاشى الضوء، وصل الرجل الكالح إلى سفح جبل في سهل واسع".
تقول القصّة إن قابيل، بعد ارتكابه جريمة قتل شقيقه، رحل وهو وزوجته عن منزل والديه ليعيشا في مكان بعيد. وقد أنجبا في ذلك المكان أطفالا. ثمّ أسّس أبناؤه في ما بعد مدينة أطلق عليها قابيل هانوك أو إدريس، على اسم طفله الأوّل.
❉ ❉ ❉
حملت حوّاء من آدم بطفلهما الأوّل وأسمياه قابيل. وبعد فترة أنجبت طفلا ثانيا أسمياه هابيل. وفي ما بعد أصبح هابيل راعيا للغنم، بينما كان قابيل يعكف على استزراع الأرض. تقول القصّة إن قابيل قدّم بعضا من نتاج الأرض التي كان يزرعها قربانا للربّ، بينما قدّم هابيل قربانا بعضا من أبكار غنمه. وقد تقبّل الربّ قربان هابيل، لكنّه لم يتقبّل قربان قابيل. لذا غضب الأخير وأحسّ بالنبذ. وذات يوم دعا قابيل شقيقه كي يذهبا معا إلى الحقل بعد أن أسرّ في نفسه أمرا. وهناك هاجم قابيل هابيل وقتله.
محور هذه القصّة هو الأنانيّة المتأصّلة عند قابيل وعدوانيّته وغيرته الشديدة. الرواية القرآنية عن القصّة تماثل تلك التي وردت في التوراة، وهي توحي بأن دافع قابيل لارتكاب الجريمة كان رفض الربّ أن يتقبّل منه قربانه.
محور هذه القصّة هو الأنانيّة المتأصّلة عند قابيل وعدوانيّته وغيرته الشديدة. الرواية القرآنية عن القصّة تماثل تلك التي وردت في التوراة، وهي توحي بأن دافع قابيل لارتكاب الجريمة كان رفض الربّ أن يتقبّل منه قربانه.
❉ ❉ ❉
قصّة قابيل وهابيل تتضمّن طبقات متعدّدة من المعاني. فالقصّة تقول لنا أن الله يفضّل قرابين اللحم على قرابين الخبز والفاكهة. كما أنها توضّح تفوّق ثقافة الرعي والترحال على ثقافة الزراعة والاستقرار. وهذه الفكرة تتكرّر في قصص العهد القديم، حيث يثور الأنبياء ضدّ شرور أهل المدن، بينما يمتدحون الرعي والعيش في الأرياف. وهناك في العالم المعاصر اليوم من لا يزالون يفضّلون الحياة في البوادي والقرى باعتبارها أكثر طهرانية ونقاءً.
لكن القصّة تتضمّن مجموعة أخرى من الأفكار التي أسهمت في تغيير تاريخ البشر وفي تحوّل الوعي الإنساني. تذكر القصّة، مثلا، أن الله وضع وصمة على قابيل بعد ارتكابه للجريمة وذلك بأن جعل بشرته سوداء وشعره مجعّدا. والغريب أن انتشار الرقّ في القرنين الماضيين في أمريكا وفي غيرها من مناطق العالم كان يُبرّر دائما بأن الأفارقة ينحدرون من سلالة قابيل، ولذا حلّت عليهم تلك اللعنة وأصبح قدرهم أن يعيشوا مستعبدين في الحياة.
وليس البيض وحدهم هم من يؤمنون بهذا الشيء، بل إن رجال الدين السود يشاطرونهم هذا الرأي أيضا ويعتقدون بأن الحال ستظلّ هكذا إلى أن يعود المسيح إلى الأرض ثانية فيرفع عنهم تلك اللعنة بعد أن يتأكّد من أنهم أصبحوا أتقياء صالحين!
لكن القصّة تتضمّن مجموعة أخرى من الأفكار التي أسهمت في تغيير تاريخ البشر وفي تحوّل الوعي الإنساني. تذكر القصّة، مثلا، أن الله وضع وصمة على قابيل بعد ارتكابه للجريمة وذلك بأن جعل بشرته سوداء وشعره مجعّدا. والغريب أن انتشار الرقّ في القرنين الماضيين في أمريكا وفي غيرها من مناطق العالم كان يُبرّر دائما بأن الأفارقة ينحدرون من سلالة قابيل، ولذا حلّت عليهم تلك اللعنة وأصبح قدرهم أن يعيشوا مستعبدين في الحياة.
وليس البيض وحدهم هم من يؤمنون بهذا الشيء، بل إن رجال الدين السود يشاطرونهم هذا الرأي أيضا ويعتقدون بأن الحال ستظلّ هكذا إلى أن يعود المسيح إلى الأرض ثانية فيرفع عنهم تلك اللعنة بعد أن يتأكّد من أنهم أصبحوا أتقياء صالحين!

بعد طرد آدم وحوّاء من جنّات عدن، اشتغلت ذرّيتهما في الأعمال البدائيّة البسيطة. إبناهما، أي قابيل وهابيل، يوصفان كأوّل مزارع وراعٍ في سلالة البشر. غير أن الاثنين مارسا أيضا شيئا لم يعرفه أبواهما في الجنّة، أي الدين.
وعلى الرغم من أن القصّة لا توحي أبدا بأن الربّ طلب منهما هذا الأمر، إلا أن الاثنين قدّما إلى الله قرابين دينيّة على هيئة جزء من غلّتهما. وعلى ما يبدو، كان الله مستاءً من قابيل لأنه قدّم قربانا من الحبوب والفاكهة، في حين انه كان يفضّل أضحية من دم كتلك التي قدّمها هابيل. هذا على الأقل ما افترضه قابيل وهابيل. يمكننا فقط أن نخلص إلى أن هابيل أصاب ثروة أفضل من تلك التي جمعها قابيل، وهذا ما انتهى إليه فهمهما.
وأيّا ما كان الأمر، فقد شعر قابيل بالغيرة من هابيل وقام بقتله. وكانت تلك أوّل جريمة قتل تُرتكب في تاريخ البشرية وأوّل حادثة عنف دينيّ.
طوال فترة مكوثهما في الجنّة، لم يقدّم آدم وحوّاء أيّ قربان لله. لكن لم يمض وقت طويل حتى قرّر ابناهما أن تلك هي الطريقة المثلى لنيل رضا الخالق. وما أن بدءا هذه الممارسة حتى انكشف شرّها المتأصّل بطريقة مأساويّة.
يذهب بعض مؤرّخي الأديان إلى انه من الصعب أن نتصوّر أن الله يمكن أن يروّج لمثل هذه العادة المشكوك فيها. وحتى الآن، ما يزال جزء كبير من اللاهوت المسيحيّ الغربيّ يرتكز على فكرة أن الله يطلب الاضحيات والقرابين لكي يتمّ استرضاؤه وتجنّب غضبه. لكن هناك من الأنبياء من قالوا صراحة بخلاف ذلك، أي أن الله ليس مهتمّا بقرابين البشر، وأن كلّ ما يطلبه منهم هو أن يعملوا بعدل ومحبّة ورحمة.
وعلى الرغم من أن القصّة لا توحي أبدا بأن الربّ طلب منهما هذا الأمر، إلا أن الاثنين قدّما إلى الله قرابين دينيّة على هيئة جزء من غلّتهما. وعلى ما يبدو، كان الله مستاءً من قابيل لأنه قدّم قربانا من الحبوب والفاكهة، في حين انه كان يفضّل أضحية من دم كتلك التي قدّمها هابيل. هذا على الأقل ما افترضه قابيل وهابيل. يمكننا فقط أن نخلص إلى أن هابيل أصاب ثروة أفضل من تلك التي جمعها قابيل، وهذا ما انتهى إليه فهمهما.
وأيّا ما كان الأمر، فقد شعر قابيل بالغيرة من هابيل وقام بقتله. وكانت تلك أوّل جريمة قتل تُرتكب في تاريخ البشرية وأوّل حادثة عنف دينيّ.
طوال فترة مكوثهما في الجنّة، لم يقدّم آدم وحوّاء أيّ قربان لله. لكن لم يمض وقت طويل حتى قرّر ابناهما أن تلك هي الطريقة المثلى لنيل رضا الخالق. وما أن بدءا هذه الممارسة حتى انكشف شرّها المتأصّل بطريقة مأساويّة.
يذهب بعض مؤرّخي الأديان إلى انه من الصعب أن نتصوّر أن الله يمكن أن يروّج لمثل هذه العادة المشكوك فيها. وحتى الآن، ما يزال جزء كبير من اللاهوت المسيحيّ الغربيّ يرتكز على فكرة أن الله يطلب الاضحيات والقرابين لكي يتمّ استرضاؤه وتجنّب غضبه. لكن هناك من الأنبياء من قالوا صراحة بخلاف ذلك، أي أن الله ليس مهتمّا بقرابين البشر، وأن كلّ ما يطلبه منهم هو أن يعملوا بعدل ومحبّة ورحمة.
❉ ❉ ❉
ترى كيف كانت طبيعة العالم الذي وجده آدم وحوّاء بعد طردهما من الجنّة؟ هل كان هناك بشر بدائيّون يعيشون خارج عدن؟
ومَن كان الطغاة العمالقة الذين تذكر بعض المصادر الدينية أنهم كانوا يعيشون على الأرض ويعيثون فيها الخراب إلى أن انقرضوا قبيل حادثة الطوفان؟ هل الله هو الذي خلقهم أم أنهم كانوا تمظهرات وتحوّلات للشيطان؟ ومن كانت زوجتا قابيل وهابيل؟
الكتب المقدّسة لا تتطرّق إلى مثل هذه الأمور. لكن يمكننا أن نفترض أن العالم خارج عدن لم يكن عالما مثاليّا. ومع ذلك كان هناك شكل من أشكال الحضارة الإنسانيّة، بل وربّما أنواع أخرى من البشر شبيهة بالإنسان. وكانت هناك مزروعات وقطعان من الحيوانات المفترسة والمستأنسة تتعايش مع الإنسان في أجواء من الصراع والخطر والموت.
الكتب المقدّسة لا تتطرّق إلى مثل هذه الأمور. لكن يمكننا أن نفترض أن العالم خارج عدن لم يكن عالما مثاليّا. ومع ذلك كان هناك شكل من أشكال الحضارة الإنسانيّة، بل وربّما أنواع أخرى من البشر شبيهة بالإنسان. وكانت هناك مزروعات وقطعان من الحيوانات المفترسة والمستأنسة تتعايش مع الإنسان في أجواء من الصراع والخطر والموت.
❉ ❉ ❉
في الفنّ المسيحيّ الذي يعود إلى القرون الوسطى، ولا سيّما فنّ القرن السادس عشر، كان قابيل يُرسم بشكل نمطيّ على هيئة يهوديّ ملتحٍ وذي شعر أشعث. وهو يقتل هابيل الذي يظهر بملامح أوربّية وشعر أشقر ويرمز للمسيح.
وقد استمرّ هذا التصوير التقليدي لعدّة قرون. وأقرب مثال عليه هو لوحة جيمس تيسو بعنوان قابيل يقود هابيل إلى الموت والمرسومة في القرن التاسع عشر. لكن في ما بعد أصبح قابيل يُصوّر كأب للمجموعات السرّية وعصابات الجريمة المنظّمة.
وكثيرا ما شكلّت قصّة قابيل وهابيل موضوعا للأعمال الدرامية المأساوية. كان قابيل يُصوّر غالبا بشعر احمر ولحية ملوّنة، كما في مسرحيّة شكسبير "سيّدات وندسور المرحات". شكسبير أيضا يذكر قابيل وهابيل على لسان كلوديوس في مسرحيّة هاملت. كما يرد ذكر الاثنين في مسرحية "بانتظار غودو" لـ سامويل بيكيت.
وفي روايته شرقي عدن ، يستدعي جون شتاينبك قصّة قابيل وهابيل ليسقطها على وقائع هجرة الأوربّيين إلى كاليفورنيا في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين.
اللورد بايرون أعاد كتابة القصّة في قصيدة له بعنوان "قابيل". وهو ينظر إلى قابيل كرمز للمزاج الدمويّ الذي أثاره نفاق هابيل وتظاهره الزائف بالتقوى. وفي الكوميديا الإلهية، يواجه قابيل العقوبة التي فرضها الله عليه لارتكابه خطيئة الحسد بعبارته المشهورة: سأصبح مطاردا وهائما على وجهي في الأرض، ومن يجدني سيقتلني".
وفي أعمال أدبيّة أخرى، أصبح اسم قابيل مرادفا للعنة المتوارثة. فالوحش في قصّة بيوولف ينحدر من سلالة قابيل. غير أن بودلير كان الكاتب الأكثر تعاطفا مع قابيل في قصيدته "هابيل وقابيل" من مجموعة أزهار الشرّ ، حيث يصوّر قابيل كممثّل لكلّ الشعوب المضطهدة في العالم.
في الرسم، كانت قصّة قابيل وهابيل احد المواضيع المفضّلة للفنّانين منذ القدم. ومن أشهر من رسمها كلّ من تيشيان وغوستاف دوري وتينتوريتو وروبنز ووليام بليك وغيرهم.
بعض من كتبوا عن قابيل وهابيل في ما بعد حلّلوا قصّتهما من منظور معاصر مع بعد دياليكتيكيّ، فأشاروا إلى أن الموت العنيف لهابيل كان نتيجة لحالة من حالات الصراع الطبقيّ المبكّرة، وأن العنف هو نتيجة حتميّة طالما أن المجتمع يصنّف الناس على أساس الثروة والسلطة، بدلا من توحيدهم على أساس التعاطف المتبادل والأخوّة الإنسانيّة.
وقد استمرّ هذا التصوير التقليدي لعدّة قرون. وأقرب مثال عليه هو لوحة جيمس تيسو بعنوان قابيل يقود هابيل إلى الموت والمرسومة في القرن التاسع عشر. لكن في ما بعد أصبح قابيل يُصوّر كأب للمجموعات السرّية وعصابات الجريمة المنظّمة.
وكثيرا ما شكلّت قصّة قابيل وهابيل موضوعا للأعمال الدرامية المأساوية. كان قابيل يُصوّر غالبا بشعر احمر ولحية ملوّنة، كما في مسرحيّة شكسبير "سيّدات وندسور المرحات". شكسبير أيضا يذكر قابيل وهابيل على لسان كلوديوس في مسرحيّة هاملت. كما يرد ذكر الاثنين في مسرحية "بانتظار غودو" لـ سامويل بيكيت.
وفي روايته شرقي عدن ، يستدعي جون شتاينبك قصّة قابيل وهابيل ليسقطها على وقائع هجرة الأوربّيين إلى كاليفورنيا في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين.
اللورد بايرون أعاد كتابة القصّة في قصيدة له بعنوان "قابيل". وهو ينظر إلى قابيل كرمز للمزاج الدمويّ الذي أثاره نفاق هابيل وتظاهره الزائف بالتقوى. وفي الكوميديا الإلهية، يواجه قابيل العقوبة التي فرضها الله عليه لارتكابه خطيئة الحسد بعبارته المشهورة: سأصبح مطاردا وهائما على وجهي في الأرض، ومن يجدني سيقتلني".
وفي أعمال أدبيّة أخرى، أصبح اسم قابيل مرادفا للعنة المتوارثة. فالوحش في قصّة بيوولف ينحدر من سلالة قابيل. غير أن بودلير كان الكاتب الأكثر تعاطفا مع قابيل في قصيدته "هابيل وقابيل" من مجموعة أزهار الشرّ ، حيث يصوّر قابيل كممثّل لكلّ الشعوب المضطهدة في العالم.
في الرسم، كانت قصّة قابيل وهابيل احد المواضيع المفضّلة للفنّانين منذ القدم. ومن أشهر من رسمها كلّ من تيشيان وغوستاف دوري وتينتوريتو وروبنز ووليام بليك وغيرهم.
بعض من كتبوا عن قابيل وهابيل في ما بعد حلّلوا قصّتهما من منظور معاصر مع بعد دياليكتيكيّ، فأشاروا إلى أن الموت العنيف لهابيل كان نتيجة لحالة من حالات الصراع الطبقيّ المبكّرة، وأن العنف هو نتيجة حتميّة طالما أن المجتمع يصنّف الناس على أساس الثروة والسلطة، بدلا من توحيدهم على أساس التعاطف المتبادل والأخوّة الإنسانيّة.
Credits
en.wikipedia.org
en.wikipedia.org