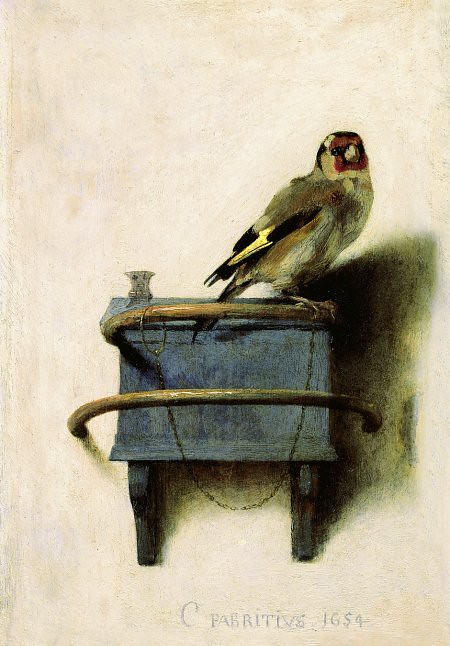غير أن الروايتين متناقضتان تماما في بعض الجوانب. فـ "الشياطين "تتّسم بطابعها الحادّ الذي يتأرجح بين الكابوس والمرح، بينما تتسم "العميل السرّي" بنبرة أكثر رصانة وكآبة. وشخصيات "الشياطين" أكثر وقصّتها أطول بكثير من سرد كونراد الأكثر تركيزا. لكن ما يجمع الروايتين هو أنهما تُصدران حكما قاسيا على من يسعون إلى اختصار طريق التغيير المجتمعي عبر العنف. وثوّار دوستويفسكي وكونراد مختلّون عقليّا ومنبوذون ومنقطعون عن الدراسة ومبذّرون وأرواحهم تائهة وعملهم لا يثمر خيرا.
والروايتان مأساويتان، حيث يموت عدد كبير من شخصياتهما الرئيسية في النهاية. واليأس والانتحار قاسمان مشتركان بينهما، وكذلك موت الأبرياء والضعفاء. وتحتوي كلّ من الروايتين على شخصية مصابة بخلل إدراكي وتعاني من سوء حظّها بالتورّط مع أشخاص غير مناسبين.
كان دوستويفسكي كاتبا متديّنا بعمق ومؤمنا بالخير الفطريّ في كلّ إنسان. وبرأيه عندما يرتكب الناس الشرّ، لا يكون ذلك لأنهم أشرار، بل لأنهم وقعوا تحت تأثير الشرّ أو الباطل.
رواية "الشياطين "تدور أحداثها في قرية روسية، وتروي قصّة الفوضى التي ألحقتها عودة المهاجرين من الغرب بحياة المدنيين. فقد جلبوا معهم أفكارا ثورية من الخارج تتعارض مع كلّ ما هو روسي ومقدّس. وهذه الأفكار هي "الشياطين" المقصودة في عنوان الرواية. وقد اقتبسه دوستويفسكي من قصّة وردت في الإنجيل.
وأحداث الرواية تتمحور حول شابّ يُدعى نيكولاي ستافروجين، اختار أن يجعل من حياته تجربة لإثبات أن الخير والشرّ ليسا سوى تحيّزات. وقد عاش حياة من التدهور الأخلاقي في الخارج، فاغتصب فتاة صغيرة ودفعها إلى الانتحار، ثم حاول موازنة خطئه بعبء بغيض، وذلك بزواجه من امرأة معاقة جسديّا وتعاني من مرض نفسي.
نظير ستافروجين هو بيوتر فيركوفينسكي، وهو شخص كاذب ومختلّ عقليّا. وعلى عكس ستافروجين، لا يشعر بأيّ ندم على أفعاله، إذ يقتل شخصين ويتسبّب في وفاة ثلاثة آخرين. ثم يفرّ في النهاية غير مكترث بمن جرّهم إلى مشروعه البغيض والعبثي.
وفيركوفينسكي لا تربطه أيّ علاقة عاطفية بأيّ شخص آخر سوى ستافروجين، لأنه يعتقد بأن هذا الشخص مفيد في قيادة ثورته. وفيركوفينسكي مقتنع بأن الدمار الذي يسعى لإشعاله في هذه البلدة الصغيرة يمكن تكراره مع مرور الوقت في جميع أنحاء روسيا، ما سيؤدّي إلى قلب النظام الاجتماعي "الاستبدادي". وهو لا يبالي إن كان الانقلاب سيُكلّف ملايين الأرواح ويقول: مائة مليون رأس، هكذا يصرخون. ولكن لماذا الخوف إذا كان الاستبداد سيأكل بعد مائة عام خمسمائة مليون رأس وليس مئة مليون؟!" لفيركوفينسكي قدرة استثنائية ومرعبة على التلاعب بالآخرين وتسخيرهم للكذب الذي وقع هو نفسه فيه.
والعدميون عند دوستويفسكي مجموعة متنوّعة: حمقى يتلاعب بهم مختلّ عقليّا لتحقيق غاياته المروّعة والخيالية وأرواح مضلّلة كان من الممكن أن يحقّقوا الخير في هذا العالم لولا إغوائهم بالفكر الثوري. وجميعهم مثيرون للشفقة باستثناء فيركوفينسكي الذي ظلّ جامدا في شخصيته حتى النهاية.
ودوستويفسكي في الرواية لا يدافع عن مجتمعه، أي روسيا القيصرية في أواخر القرن التاسع عشر، ولا يدّعي كمالها، وإنما يقصر اهتمامه في" الشياطين"على أولئك الذين يسعون إلى تقويض استقرار الدولة القومية من خلال سفك الدماء.
ويردّد كونراد هذا الشعور في رواية "العميل السرّي"، التي تدور أحداثها بعد نحو ثلاثين عاما من الفترة التي تغطّيها رواية "الشياطين"، في لندن في مطلع القرنين التاسع عشر والعشرين. وفوضويو كونراد أقلّ إثارةً للإعجاب من عدميي دوستويفسكي. فهناك كارل يوندت، الذي أعلن نفسه إرهابيا وهو في الحقيقة رجل عجوز هزيل في حالة صحّية متدهورة. وهناك ميكايليس الذي أُطلق سراحه بعد مشاركته في عملية هروب من السجن أسفرت عن مقتل شرطي.
والعضو الخطير الوحيد بين هؤلاء هو البروفيسور، وهو شخص منعزل ومهووس هدفه الرئيسي في الحياة هو تطوير "المفجّر المثالي". كما أنه مجرّد من أيّ عاطفة ومعتاد على الفقر والعزلة ومتمسّك تماما بأحلامه التدميرية. وكونراد يُصوّره كرجل مظلوم في مجتمع لم يدرك مواهبه وشخص مجروح يسعى للتعويض عن ذلك بلعب دور خارج الحياة العادية.
والبروفيسور هو من وفّر المادّة اللازمة للحدث المحوري في القصّة، وهو انفجار مرصد غرينتش. وقد اتضح أنه عمل فاشل من قِبل العميل السرّي الذي يحمل عنوان الرواية.
ومثل دوستويفسكي، يركّز كونراد على البعد الإنساني أكثر من البعد السياسي ويرسم صورة مقنعة تماما للشخصيات العادية غير السياسية في قصّته. فهم أناس حقيقيون يعيشون حياة حقيقية وتربطهم علاقات صادقة ولا يسع أيّ قارئ إلا أن يتعاطف معهم.
ووجهة نظر كونراد هي أن الناس العاديين هم من يعانون الكثير من المشقّة والألم، وهم من تُدمّر حياتهم ويُحرمون حتى من حقّهم في الأمان، بينما تستمرّ الحكومات وأجهزة الدولة في العمل بغضّ النظر عن كلّ ذلك. مارك هاركن
❉ ❉ ❉
❉ ❉ ❉
ما من شك في أننا محظوظون برؤية صور رمبراندت الشخصية. صِدقُه الوحشي والذي لا يرحم في تصوير نفسه يتجاوز الزمن، وهو جوهر الفن. إن عيون رامبرانت تحدّق فينا بحنان وتعاطف وحزن وشفقة وفهم وتأمّل في الذات. وهو يخبرنا بما يعنيه أن تكون إنسانا. الجسد ينتابه الوهن ويرتخي، والعينان الصغيرتان قد رأتا كلّ شيء ولم يفاجئهما شيء والجسد ضعيف، ومهما كانت الملابس باهظة الثمن فإنها تنكمش وتضيق تحت ثقل أعباء الوجود.
عندما أشعر بالملل والانسداد الفنّي والعاطفي، أذهب إلى متحف لألقي نظرة على رمبرانت وأخرج منه محصّنا ومنغمسا في الحياة. وبصفتي رسّاما، كان رمبرانت دائما هو الشخص الوحيد. كان أوّل مشروع لي في مدرسة الفنون منذ 45 عاما عبارة عن نسخة من لوحة "مارغريتا دي غِير، زوجة ياكوب تريب" التي تعود إلى عام 1661 والموجودة في الناشيونال غاليري.
وقد اعتدت أن أنام كلّ ليلة في غرفة بها نقوش لرامبرانت على الحائط. وسمّيت ابنتي على اسم زوجته الحبيبة ساسكيا. وأقوم برحلات منتظمة إلى كينوود هاوس في لندن لزيارة صورته الذاتية ذات الدائرتين، وإلى متحف رايكس في أمستردام لزيارة "العروس اليهودية"، والتي كانت نسخة طبق الأصل منها في مرسمي منذ بدأت الرسم لأوّل مرّة.
ذات يوم، اعترفَ فان غوخ لصديق أنه كان سيضحّي بكلّ سرور بعشر سنوات من حياته ليجلس أسبوعين مع كسرة خبز فقط أمام هذه اللوحة. إنها تتحدّث عن الحبّ والحنان. ولكن في أبعادها الثلاثة المضطربة، هي أيضا نموذج لمستقبل الرسم.
على غرار جاكسون بولوك، يرسم رمبرانت بالجسد والروح، وتعمل السَّكينة التي تثيرها لوحته بقوّة إيمائية نربطها أكثر بالقرن العشرين وليس بالفنّ الهولندي في القرن السابع عشر. إن كلّ عمل من اعمال رمبرانت يلهمنا الشعور والتفكير ورؤية أن معنى الفنّ والحياة هو دفع كلّ ما هو ممكن إلى أقصى حدوده. إذهب وانظر! روبن ريتشموند
rembrandthuis.nl
online-literature.com