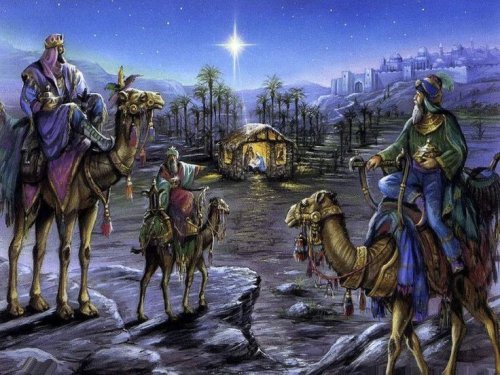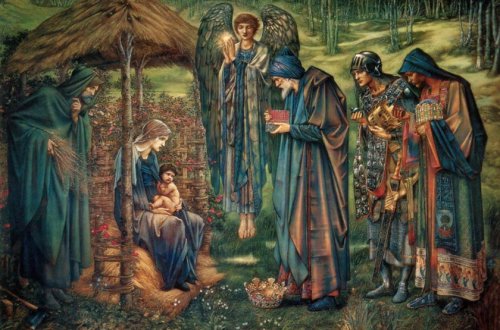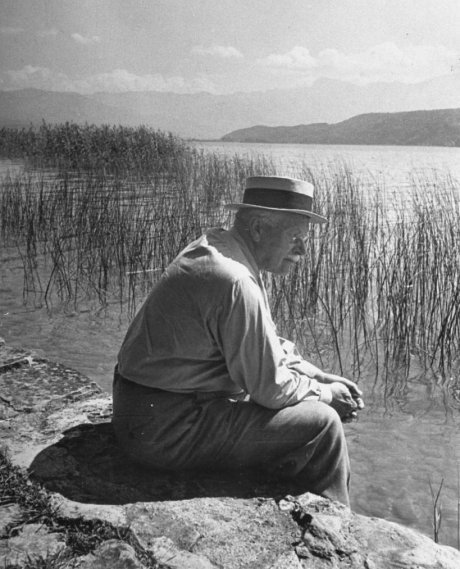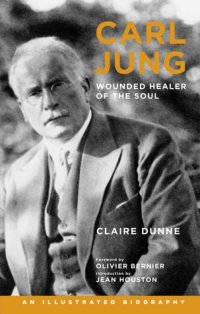قطار إلى لشبونة

ترى هل ساورك يوما شعور مفاجئ بالحاجة لأن تتخلّى عن حياتك السابقة وراء ظهرك وتبدأ حياة جديدة ومختلفة؟
ما يحدث في كثير من الأحيان هو أن حادثة واحدة وغير متوقّعة يمكنها أن تساعدنا على أن نقهر خوفنا الغريزي من المجهول ونبدأ حياة واعدة ومثمرة وتستحقّ أن تُعاش.
هذه هي الفكرة التي تتمحور حولها رواية
قطار ليلي إلى لشبونة للفيلسوف والكاتب السويسري باسكال ميرسييه التي أصبحت احد أكثر الكتب مبيعاً بعد ترجمتها من الألمانية للانجليزية، ثمّ بعد أن تحوّلت إلى
فيلم سينمائي قبل حوالي سنتين.
في الرواية يحكي المؤلّف عن رحلات مدرّس أدب كلاسيكي سويسري يُدعى ريمون غريغوريوس الذي يحاول استكشاف حياة طبيب برتغالي يدعى اماديو دي برادو أثناء حكم سالازار للبرتغال.
برادو نفسه ليس طبيبا فحسب، بل يمكن أيضا اعتباره مفكّرا ومهتمّا بالأدب. كما انه دائم التأمّل في أحوال العالم وفي التجارب الإنسانية. والقارئ يلمس عقليّته المتوقدة من خلال سلسلة من الملاحظات المكتوبة التي يحاول فيها استكشاف مدى وعي وقدرة الإنسان على اكتشاف ذاته وقدرة اللغة على تشكيل وتفكيك تجارب البشر ورغباتهم وهويّاتهم.
في ما يلي بعض ملاحظات برادو التي يجمعها ويقرؤها غريغوريوس في ثنايا هذه الرواية..
نترك شيئا من أنفسنا خلفنا عندما نغادر مكانا ما. إننا نمكث هناك حتى وان كنّا قد ذهبنا. وفي دواخلنا أشياء لا يمكن أن نجدها مرّة أخرى إلا عندما نعود إلى هناك؛ إلى نفس المكان.
أهرب عندما يبدأ شخص ما يفهمني. لا أريد لأحد أن يفهمني بالكامل. أريد أن أعيش حياتي غير معروف. عمى الآخرين هو بالنسبة إليّ سلامتي وحرّيتي.
عندما نتكلّم عن أنفسنا وعن الآخرين أو عن أيّ شيء، فإننا نكشف عن أنفسنا في كلماتنا. إننا نريد أن نُظهر ما نفكّر فيه وما نشعر به. وبذا نوفّر للآخرين فرصة لأن يُلقوا نظرة إلى داخل أرواحنا.
من الحكمة أن نبدأ في تحقيق الأمنيات الصغيرة التي طالما حلمنا بها، وأن نُصلح خطأ الاعتقاد بأنه سيتوفّر لدينا وقت في المستقبل لتحقيقها. قم بالرحلة التي طالما حلمت بالقيام بها، تعلّم لغة ما، إقرأ تلك الكتب، اشترِ هذه القطعة من المجوهرات، إقضِ ليلة في ذلك الفندق المشهور. لا تمنّ على نفسك بتحقيق هذه الأشياء الصغيرة. الأشياء الأكبر هي جزء من ذلك: تخلّ عن الوظيفة المملّة، اخرج من تلك البيئة الكريهة، إفعل شيئا يجعلك تبدو على حقيقتك أكثر ويجعلك اقرب إلى نفسك.
الخوف من الموت يمكن أن يوصف أحيانا بأنه خوف الإنسان من أن لا يكون قادرا على أن يكون الشخص الذي كان يخطّط لأن يكونه.
كيف سيكون عليه الحال بعد الجملة الأخيرة؟ كان دائما يخاف من آخر جملة. وابتداءً من منتصف أيّ كتاب، كان يتعذّب دائما من فكرة انه لا بدّ، ومن المحتّم، أن تكون هناك جملة أخيرة.
أشعر بالحزن على الأشخاص الذين لا يسافرون. عدم قدرة الإنسان على أن يتوسّع نحو الخارج يُفقده القدرة على أن يتوسّع إلى الداخل أيضا. والإنسان الذي لا يسافر محروم من إمكانية التنزّه داخل نفسه واكتشاف من هو وما الذي يمكن له أيضا أن يحقّقه.
حياتنا عبارة عن أنهار تتهادى منحدرة باتّجاه ذلك البحر اللانهائي الذي لا يمكن سبر غوره: القبر الصامت.
الشعور ليس هو نفس الشعور عندما يأتي في المرّة الثانية. إنه يموت أثناء وعينا بعودته. إننا نتعب ونملّ من مشاعرنا عندما تأتي بشكل متكرّر وتبقى معنا أطول ممّا ينبغي.
❉ ❉ ❉
بريولوف وملهمته

كانت الكونتيسة يوليا سامويلوفا ملهمة الرسّام الروسي
كارل بريولوف . كانا مرتبطين بقصّة حبّ، وقد رسم لها العديد من اللوحات من بينها هذه اللوحة التي تظهر فيها وهي تمتطي حصانا برفقة ابنتها.
كانت سامويلوفا تنتمي إلى المجتمع البورجوازي، وكان والدها جنرالا يمتّ بصلة قرابة من بعيد لكاثرين العظيمة.
وقد تزوّجت من احد الأمراء. لكن الزواج لم يستمرّ طويلا، وراجت العديد من التكهّنات عن أسباب الطلاق، منها أن يوليا كانت تتخذ لنفسها عشّاقا كثيرين.
كان منزلها مقصدا لعشرات الزوّار والأشخاص المهمّين الذين كانت تقدّم لهم الأطعمة والمشروبات بسخاء. وربّما كان كرم الضيافة عندها يتجاوز أحيانا الحدود المتعارف عليها.
انتقلت الكونتيسة يوليا سامويلوفا إلى ايطاليا بعد أن تركت عاصمة روسيا. وفي إثرها سار عدد من الشائعات وأحاديث النميمة. وفي ميلانو، أصبح الرسّام كارل بريولوف من بين من يتردّدون على قصرها.
وقد لاحظ الناس التغيير الذي طرأ على سلوكها. فقد أصبحت تُعامل الرسّام كما لو انه قدّيس. وكان هو قريبا جدّا منها وكانت معجبة بفنّه. كتبت له ذات مرّة تقول: لا احد في هذا العالم معجب بك ويحبّك بمثل ما أنا معجبة بك ومحبّة لك. احبّك أكثر ممّا استطيع قوله. وسأظلّ احبّك إلى أن يواريني القبر".
ولم تكن سامويلوفا وبريولوف يخفيان عن الناس علاقتهما الحميمة. لكن حبّهما كان غريبا، إذ لم تكن تخالطه غيرة. كانت تصله رسائلها حتى عندما يكون بعيدا عنها. "اخبرني أين أنت الآن، ومن تحبّ أكثر: يوليا أم الأخرى"؟ كتبت له ذات مرّة.
ملامح الكونتيسة تظهر مثل الهاجس في العديد من لوحات بريولوف. في لوحته المشهورة
آخر أيّام بومبي ، منح وجهها لامرأتين، ثم رسم نفسه كرجل وسيم وأشقر الشعر يحاول الاختباء من حمم النار المنهمرة بوضع كرّاس على رأسه. حتى رسوماته الأخرى تحتوي على وجوه تشبه وجه ملهمته الأسطورية يوليا.
علاقة يوليا سامويلوفا وكارل بريولوف انتهت فجأة ولأسباب غير معروفة. وقد تزوّجت بعده أربع مرّات، كان آخرها عند بلوغها سنّ الستّين. ومع ذلك لم تذق في أيّ من زيجاتها الأربع طعم السعادة. كما لم تعد إلى روسيا بعد ذلك أبدا، واستمرّت تقيم في باريس إلى حين وفاتها في العام 1875م.
❉ ❉ ❉
استراحة موسيقية
لم أكن اعرف هذه المقطوعة من قبل. لكن لأنني استمعت لها مرارا مؤخّرا واستمتعت بها، وجدت أنه قد يكون من المفيد أن أضعها هنا. سوناتا الكمان رقم 378 مقطوعة تأمّلية كتبها موزارت في عام 1779 وأهداها إلى تلميذته جوزيفا فون اورنهامر مجاملة لأبيها الثريّ.
ومع أن هذه السوناتا ليست من بين أشهر ما كتبه موزارت، إلا أنها وُصفت في وقتها بأنها فريدة من نوعها وغنيّة بالأفكار الجادّة وبالشواهد التي تؤكّد العبقرية الموسيقية لصاحبها.
من أشهر مؤلّفات موزارت الأخرى كونشيرتو الكمان رقم 3 والمؤلّف من ثلاث حركات. وقد كتب هذا الكونشيرتو عام 1775 وعمره لم يكن قد تجاوز التاسعة عشرة.
وكان موزارت يسمّيه كونشيرتو ستراسبورغ، لأنه استخدم في الحركة الثالثة منه جزءا من رقصة كانت تشتهر بها هذه المدينة.
موزارت ألّف خلال حياته القصيرة خمسة كونشيرتوهات للكمان. ويقال، مع أن هذا ليس مؤكّدا، انه ألّفها جميعا في نفس تلك السنة. غير أن هذا الكونشيرتو ظلّ هو الأكثر شعبية من بين الكونشيرتوهات الخمسة بسبب جمال وبساطة أنغامه.
❉ ❉ ❉
دراما كونية

من الحقائق العلمية التي باتت مؤكّدة اليوم أن الكون في حالة تمدّد دائم ومستمرّ. العالِم الفلكيّ ادوين هابل قاس تمدّد الكون ووجد أن المجرّات تندفع بعيدا عنّا بمعدّل 74 كيلومتر في الثانية كل ميغا بارسيك. والميغا بارسيك يساوي أكثر من ثلاثة ملايين سنة ضوئية.
لكن إذا كان الكون يتمدّد فعلا، فلماذا تبدو مجرّتنا درب التبّانة على مسار تصادمي مع مجرّة اندروميدا؟ أليس من المنطقي أن تتراجع المجرّتان معا إلى الوراء بنفس تلك الوتيرة من السرعة الهائلة؟!
من السهل تصوّر أن المجرّات تتحرّك بعيدا عن بعضها البعض. لكن الدلائل على الاصطدامات بين تلك العوالم الهائلة والعملاقة تملأ أرجاء الكون، ما يعني أن المجرّات تتحرّك بعيدا وترتطم ببعضها البعض، وهذا يحدث كثيرا وبوتيرة اكبر مما نظنّ.
المجرّة التي تُعتبر جارتنا القريبة، أي اندروميدا، تتحرّك باتجاه مجرّتنا درب التبّانة بمعدّل حوالي 250 ألف ميل في الساعة، وهي سرعة تكفي لأن تنقلك إلى القمر في ظرف ساعة واحدة فقط.
والفضل في ذلك هو لجاذبية المادّة المظلمة التي تحيط بالمجرّتين وتشدّهما إلى بعضهما بشكل وثيق، لدرجة أنهما يقاومان تمدّد الكون، وبدلا من ذلك تنجذبان إلى بعضهما البعض.
وعندما يحدث الاصطدام الرهيب والمحتّم بينهما، وهو أمر لا يُحتمل أن يشهده البشر، فإنهما سيخلقان مجرّة واحدة بيضاوية الشكل، بينما سيتسبّب الاندماج بينهما في انفجار هائل يؤدّي إلى تشكّل نجوم وثقوب سوداء بالغة الضخامة تأخذ مكانها في قلب المجرّتين.
واندماج المجرّتين لن ينتهي هنا. فتوأم اندروميدا أو مجرّتها الجارة المسمّاة
ترايانغولوم "أو المثلّث"، والتي تتّصل مع المجرّتين بالمادّة المظلمة، سوف تنضمّ هي أيضا إلى الاصطدام، وسيتطلّب الأمر بليوني سنة أخرى لكي تندمج مع "ميلكوميدا" بشكل كامل.
مجرّة درب التبّانة مساحتها مائة ألف سنة ضوئية. ومع ذلك يمكن أن تضع خمسين درب تبّانة داخل المجرّة المسمّاة IC 1101، وهي أكبر مجرّة اكتُشفت حتى الآن.
أما اندروميدا، الأقرب إلى مجرّتنا، فتقع على بعد مليونين ونصف المليون سنة ضوئية فقط. في وسط هذه المجرّة، يوجد ثقب أسود ضخم يشبه مكنسة كهربائية هائلة. وهذا الثقب قويّ جدّا لدرجة أنه حتى الضوء لا يمكنه الإفلات منه.
وفي عام 2005، اقترب تلسكوب الفضاء هابل من اندروميدا والتقط صورا مكبّرة لمركزها كشفت عن وجود قرص أزرق على شكل فطيرة يدور بالقرب من الثقب الأسود. وأظهر مزيد من التحليل أن هذا لم يكن مجرّد غبار ساخن، بل كان وهجا قادما من ملايين النجوم الزرقاء الفتيّة.
وهذه النجوم تدور حول الثقب الأسود بسرعة تصل إلى أكثر من مليوني ميل في الساعة. وهي سرعة تكفي لإكمال الدوران حول الأرض في أربعين ثانية فقط.
المجرّات عوالم رائعة وجميلة. لكنها أحيانا تتصرّف مثل أكلة اللحوم فيفترس بعضها بعضا بطريقة متوحّشة. والمجرّات الضخمة الحجم، مثل مجرّتنا، ما تزال تلتهم مجرّات اصغر حجما وتهضمها فتزداد ضخامة واتّساعا.
❉ ❉ ❉
لوحة كاملة

يمكن القول أن هذه اللوحة محكمة في كلّ شيء. وقد رُسمت ببراعة ولُوّنت بأفضل طريقة. إنها لوحة رائعة وبلا عيوب، من حيث نوعية الطلاء وعمل الفرشاة والتناغم الرائع بين الألوان والتفاصيل والتعبيرات على الوجوه.
بعض النقّاد يقولون إن من الصعب الحكم على الرسّام من خلال قياس اللوحة أو حجمها. وهذه اللوحة ضخمة وتستحقّ أن يشاد بنجاح الرسّام في تنفيذها، إذ عندما يُرسم كلّ شيء بنجاح مذهل فإن ذلك يُعتبر انجازا في حدّ ذاته.
صحيح أن لـ يواكين سورويا لوحات أخرى جميلة كثيرة، لكن لا يمكن مقارنة لوحته هذه بأيّ شيء آخر. وقد رسمها في سنواته المبكّرة عندما كان تأثير مواطنه فيلاسكيز عليه واضحا.
اسم اللوحة
إصلاح الشراع ، وقد رُسمت في حديقة منزل. وفيها يظهر جماعة من صيّادي السمك وهم يخيطون مع بضع نساء شراع سفينة في ضوء شمس البحر المتوسّط التي تتغلغل أشعّتها من بين أغصان الشجر.
شارك سورويا بهذه اللوحة في عدّة معارض دولية، ففاز عليها بالميدالية الذهبية الأولى في معرضين، واحد أقيم في ميونيخ والثاني في فيينا.
في بداياته، سافر سورويا في بعثة دراسية إلى ايطاليا، وقضى وقتا في روما حيث أتقن تدريبه الأكاديمي، كما عرّف نفسه بأعمال الرسّامين القدامى والمعاصرين.
وقد سمحت له تلك البعثة أيضا بزيارة باريس، حيث تعرّف على الرسم الأكاديمي الواقعي الذي ألهمه رسم المواضيع الاجتماعية.
لوحة إصلاح الشراع، جسّد فيها سورويا آثار ضوء الشمس الذي أصبح علامة فارقة على فنّه. وهناك لوحة أخرى له تشبه هذه اللوحة هي
العودة من الصيد ، وهي لوحة عظيمة أيضا في تصويرها وفي تنفيذها.
Credits
bookforum.com
britannica.com
universetoday.com