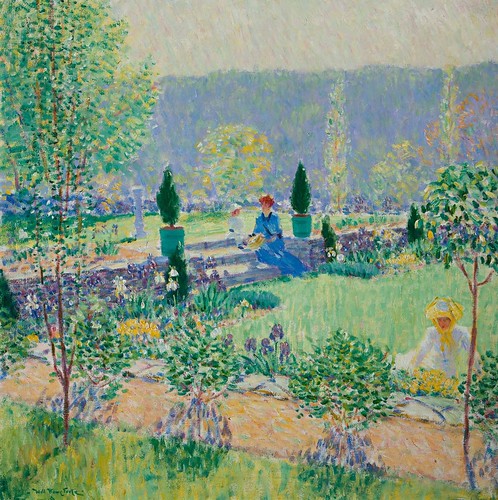ثم أثار كاتب آخر الجانب الفنّي لهذا السؤال بينما أغفل الجانب الفلسفي عندما طرح السؤال بصيغة مختلفة قليلاً: إذا سقطت شجرة على جزيرة غير مأهولة، فهل سيكون هناك أيّ صوت؟" وأعطى إجابة أكثر تقنيةً بقوله: الصوت هو اهتزاز ينتقل إلى حواسّنا من خلال آليّة الأذن، ولا يتمّ التعرّف عليه كصوت إلا في مراكز أعصابنا. سيؤدّي سقوط الشجرة أو أيّ اضطراب آخر إلى إحداث اهتزاز في الهواء. وإذا لم تكن هناك آذان تسمع، فلن يكون هناك صوت".
في إحدى جولات آينشتاين اليومية مع زميل له، توقّف فجأة والتفتَ إلى الزميل قائلا: هل تعتقد حقّا أن القمر موجود فقط إذا نظرت إليه؟". هل يمكن لشيء أن يوجد دون أن يُدرَك بالوعي؟ وهل الصوت لا يكون صوتا إلا إذا سمعه شخص ما؟!
الموضوع الفلسفي الذي يطرحه السؤال يتعلّق بوجود الشجرة "والصوت الذي تنتجه" خارج الإدراك البشري. فإذا لم يكن هناك أحد حول الشجرة ليراها أو يسمعها أو يلمسها أو يشمّها، فكيف يمكن القول إنها موجودة؟! وماذا يعني أن نقول إنها موجودة عندما يكون هذا الوجود غير معروف؟ من وجهة نظر علمية، هي موجودة والبشر هم القادرون على إدراكها.
الصوت يمكن تعريفه بأنه إدراكنا لاهتزازات الهواء. وبالتالي، لا وجود للصوت إذا لم نسمعه. وعندما تسقط شجرة، تتسبّب الحركة في اضطراب الهواء وإرسال موجات هوائية. هذه الظاهرة الفيزيائية، التي يمكن قياسها بأدوات أخرى غير آذاننا، موجودة بغضّ النظر عن إدراك الإنسان لها بالرؤية أو السماع. وإذا جمعنا هذه الخطوط الفكرية معا، يمكننا القول أنه على الرغم من أن الشجرة الساقطة ترسل موجات هوائية، لكنها لا تنتج صوتا إذا لم يكن هناك إنسان على مسافة، بحيث تكون موجات الهواء قويّة بما يكفي ليتمكّن ذلك الإنسان من إدراكها. ومع ذلك، إذا عرّفنا الصوت بأنه الموجات نفسها، فسيوجد صوت.
هل يمكننا أن نفترض أن العالم غير الملاحَظ يعمل بنفس الطريقة التي يعمل بها العالم الملاحَظ؟ إذا توقّف البشر عن الوجود، فإن الصوت سيستمرّ في الانتقال وستسقط الأجسام الثقيلة على الأرض بنفس الطريقة تماما، على الرغم من أنه من المفترض أنه لن يكون هناك من يعرف ذلك.
❉ ❉ ❉
لا يُعرف الكثير عن حياة بهزاد. وما نعرفه هو أنه وُلد في هيرات بأفغانستان وعرف اليُتم في سنّ مبكّرة. ثم تعلّم الرسم على يد الرسّام البارز ميراك الذي علّمه من الأساليب الفنّية ما يناسب أذواق الطبقة الراقية آنذاك.
وعندما ظهرت موهبته أكثر، نال إعجاب كبير وزراء هيرات الشاعر المشهور مير علي شير نوائي. وبدأ يرسم دواوين الشعر المشهورة، ما لفتَ انتباه سلطان هيرات حسين بايقرا الذي اشترى هو ورعاة البلاط أعماله لتُعرض في القصر. وفيما بعد، أصبح بهزاد مديرا للمرسم الملكي للشاه إسماعيل الأوّل الصفوي في تبريز.
وقد أصبح اسم هذا الرسّام مرادفا للبراعة الفنيّة الرفيعة التي أظهرها الفنّانون في عهد التيموريين، ولاحقا في عهد الصفويين فيما يُعرف اليوم بأفغانستان وإيران. ومن الأمثلة الرائعة على براعته طريقة تجسيده للعمارة وكيفية خلق المنظور.
كما أن صوره تنقل إحساسا بالحالة المزاجية للشخصيات بطريقة أكثر دقّة وتعبيرا من المخطوطات الفارسية التقليدية. وتُظهِر لوحاته أيضا قدرته على جعل إيماءات الشخصية مليئة بالحيوية والحركة. ومع ذلك، فإن دقّة الرسم والتحكّم في التنفيذ رائعة أيضا، وهذه كانت سمة مميّزة للرسم في هيرات في القرن الخامس عشر.
وتُعدّ الدقّة في النمط والخطّ والتصميم أهمّ إرث لبهزاد. لكن الأجيال اللاحقة انفصلت عنه ورسمت أشكالا جامدة وبلا حياة. وحاليّا، تزيّن أعماله المخطوطات المحفوظة في متاحف ومكتباتٍ عدّة حول العالم، بما في ذلك دول مثل المملكة المتحدة وسويسرا والولايات المتحدة وروسيا وتركيا وإيران ومصر. ورغم أن العديد من المخطوطات والرسومات الفردية نُسبت له، إلا أن القليل منها فقط مُعتمَدة رسميّاً على أنها من أعماله.
❉ ❉ ❉
أمسك الأوّل بالطائر، لكنه كان خائفا جدّا من أن يتمكّن من التحرّر من قبضته والطيران بعيدا، لذا ضغط على العصفور بقوّة، وعندما فتح راحة يده، كان العصفور قد مات. وعندما رأى المرشّح الثاني الامتعاض على وجه ستالين، خاف من تكرار خطأ منافسه، فخفّف قبضته كثيراً حتى تَحرّر العصفور وطار بعيداً.
نظر ستالين إلى الإثنين بازدراء، وأمر مساعديه أن يحضروا له عصفورا! ثم أمسك بالطائر من ساقيه، وببطء قام بنزع كلّ الريش من جسمه الصغير، ريشةً بعد أخرى. ثم فتح كفّه، فإذا بالطائر متكوّم هناك، يرتجف عاريا وبحال من العجز واليأس. نظر ستالين الى العصفور بشفقة مصطنعة ثم قال لمن حوله وهو يبتسم: كما ترون، إنه حتى ممتنّ للدفء الإنساني الذي وجده في يدي!".
❉ ❉ ❉
❉ ❉ ❉
◦ ربّما لم يوجد لاو تزو قطّ، وحتى لو وُجد فمن المؤكّد أنه لم يؤلّف كتاب الطاو "تاو تي تشينغ"، وهو الكتاب الذي يُنسب إليه عادةً. قد يكون لاو تزو شخصية خيالية، وحتى لو وُجد، فإن الكتاب الذي يحمل اسمه لا يحتوي إلا على القليل من كلماته الحقيقية، وربّما كُتب بعد حوالي ستمائة عام أو أكثر من حياته المفترضة.
ومن بين جميع الشخصيات التي تدّعي الطاوية أنها جزء منها خلال فترة الازدهار الفكري الاستثنائية بين القرنين السادس والثالث قبل الميلاد، وحده تشوانغ تزو يبرز من بين الضباب كشخصية مميّزة، بل وإحدى أكثر الشخصيات إثارةً للاهتمام وفكاهةً ومتعةً في الفكر والفلسفة الصينية ككل. مارتن بالمر
◦ قال ستيفن هوكينغ ذات مرّة بأن البشر لم يتبقَّ لهم سوى ألف عام على الأرض، وأننا إذا أردنا البقاء على قيد الحياة، فسوف نضطرّ إلى الانتقال إلى مكان آخر".
وأنا آمل أن يحدث ذلك، ليس فقط للبشر، بل للحياة ككلّ. هل سنظلّ بشرا في تلك المرحلة؟ هذه مسألة انتخاب. فالمسار الطبيعي للأحداث وعلم الأحياء، إمّا أن ينقرض نوع ما أو ينقسم إلى أنواع عديدة ناجحة، فينتهي به الأمر إلى عشرة أنواع أو مئة. هذا هو جوهر التطوّر. لذا أعتقد أنه من المرجّح أن يحدث هذا للبشر أيضا. ولو كنت سأعيش على المرّيخ، لوددت أن أعيش فيه أوّلا لأتمكّن من التجوّل في مناخ شديد البرودة. فريمان دايسون
◦ الألم والمعاناة أمران لا مفرّ منهما دائما للأذكياء وأصحاب القلوب الرحيمة. أعتقد أن العظماء حقّا لا بدّ أن يحزنوا كثيرا في حياتهم على هذه الأرض. دوستويفسكي
◦ أمّة محارِبة كالألمان، بلا مدن ولا آداب ولا فنون ولا مال، وجدت تعويضا عن هذه الحالة الوحشية في التمتّع بالحرّية. لقد ضمن لهم فقرهم الحرّية، لأن رغباتنا وممتلكاتنا هي أقوى قيود الاستبداد. إدوارد غيبون
◦ بعد قليل سأرحل عنكم. لا أدري إلى أين. من العدم أتينا وإلى العدم نذهب. ما الحياة سوى وميض فراشة في الليل، أنفاس جاموس في الشتاء، ظلّ صغير يركض على العشب ويختفي عند الغروب. الزعيم بلاك فوت
❉ ❉ ❉
ومنذ ذلك اليوم، خُصّص للأسد حيوان يفترسه يوميّا. وفي أحد الأيّام، جاء الدور على أرنب عجوز ليُجهّز للمائدة الملكية، ففكّر في مآل أمره وهو يسير الى عرين الأسد وقال في نفسه: ما دمتُ سأموت على أيّ حال فسأذهب إلى موتي على مهل."
كان الجوع قد عضّ الأسد ونفذ صبره وهو ينتظر الأرنب. ولما رآه يقترب منه زأر بغضب وقال: كيف تجرؤ على التأخير في المجيء كلّ هذا الوقت؟" أجابه الأرنب: سيّدي، لستُ أنا المذنب. لقد أوقفني أسد آخر على الطريق ولم يتركني أمضي إلا بعد أن أقسمت له بأنني سأعود بعد أن أبلغ جلالتك."
وهنا صاح الملك ذو القلب الشرس بغضب وقال: سنذهب أنا وأنت من فورنا لتريني أين يعيش ذلك الأسد الوقح." وسار الاثنان معا حتى وصلا إلى بئر عميقة، فتوقّف عندها الأرنب وقال للأسد: فليأتِ سيّدي الملك وينظر إليه." ولما اقترب الأسد، ورأى انعكاس صورته في ماء البئر، تملّكه الغضب وهاج وماج، ثم ألقى بنفسه في البئر. ولم يخرج منها أبدا.
musee-orsay.fr/en
physicsworld.com