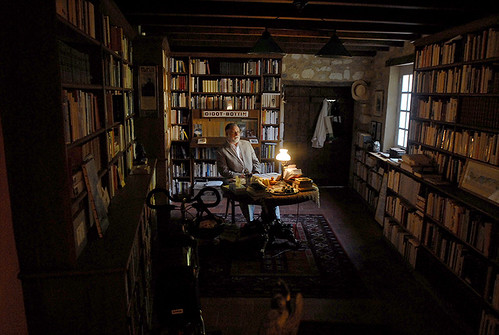هناك أوجه شبه متعدّدة بين كلّ من ليوناردو دافنشي وميكيل انجيلو. فقد اعتُبر الاثنان معلّمَين وممثلين للفنّ الكلاسيكي اليوناني والروماني. كما عملا كفنّانين تجاريَين لدى الكنيسة واستفادا من رعاية رجال الدين ودعمهم لهما. والاثنان أيضا أنتجا فنّاً تحدّى الزمن وعاش مئات السنين وما زال يحظى بتقدير الناس إلى اليوم.
وقيل أيضا أن فنّ دافنشي يّتسم بالكمال، لكنه لا يثير شعورا في نفس المتلقّي. يكفي مثلا أن تنظر إلى الموناليزا أو العشاء الأخير مرّة أو مرّتين فتُعجب بحرفية الرسّام وجمال الرسم، لكن هذا لا يحرّك فيك أيّ شعور ولا يثير بداخلك أيّ أسئلة.
وعلى العكس من ذلك، فإن منحوتات ميكيل انجيلو مليئة بالحركة والدراما والقصص المثيرة. ولهذا سيُكتب لفنّه الخلود والبقاء أكثر من دافنشي الذي شغله انهماكه بالعلوم والفلك والهندسة عن إنتاج فنّ حقيقي يحرّك العقل ويحرّض على الأسئلة.
من ناحية أخرى، كانت شخصيتا الاثنين متعارضتين من عدّة أوجه، فليوناردو كان رجلاً اجتماعيّا يحبّ ارتداء الملابس الأنيقة وحضور مناسبات النبلاء وأعيان المجتمع. لكن ممّا يُعاب عليه تركه العديد من أعماله دون أن يكملها، لأنه كان متعدّد الاهتمامات وكان يحبّ دائما التركيز على أشياء جديدة. أما ميكيل أنجيلو فكان رجلاً مقتصدا وذا شخصية خشنة وغضوبة، ولكن على عكس ليوناردو كان حازما ويتحمّل مجهودا بدنيّا هائلاً لنحت أعماله.
وتخبرنا روايات السيرة التي كُتبت عنهما أن ليوناردو كان ساحرا وأنيقا، بينما لم يكن لدى ميكيل انجيلو سوى القليل من الوقت للتباهي أو متابعة الموضة. وقد استخدم كلاهما أساليب مختلفة للحصول على عملاء مرموقين. وساعدت الكاريزما الشخصية لليوناردو في عرض أعماله على الرعاة الأثرياء كعائلة ميديتشي القويّة في فلورنسا، بينما كان الرعاة يثقون في اجتهاد ميكيل أنجيلو والتزامه، وهو ما بدا أن ليوناردو كان يفتقر إليه أحيانا.
وقيل أيضا أن فنّ دافنشي يّتسم بالكمال، لكنه لا يثير شعورا في نفس المتلقّي. يكفي مثلا أن تنظر إلى الموناليزا أو العشاء الأخير مرّة أو مرّتين فتُعجب بحرفية الرسّام وجمال الرسم، لكن هذا لا يحرّك فيك أيّ شعور ولا يثير بداخلك أيّ أسئلة.
وعلى العكس من ذلك، فإن منحوتات ميكيل انجيلو مليئة بالحركة والدراما والقصص المثيرة. ولهذا سيُكتب لفنّه الخلود والبقاء أكثر من دافنشي الذي شغله انهماكه بالعلوم والفلك والهندسة عن إنتاج فنّ حقيقي يحرّك العقل ويحرّض على الأسئلة.
من ناحية أخرى، كانت شخصيتا الاثنين متعارضتين من عدّة أوجه، فليوناردو كان رجلاً اجتماعيّا يحبّ ارتداء الملابس الأنيقة وحضور مناسبات النبلاء وأعيان المجتمع. لكن ممّا يُعاب عليه تركه العديد من أعماله دون أن يكملها، لأنه كان متعدّد الاهتمامات وكان يحبّ دائما التركيز على أشياء جديدة. أما ميكيل أنجيلو فكان رجلاً مقتصدا وذا شخصية خشنة وغضوبة، ولكن على عكس ليوناردو كان حازما ويتحمّل مجهودا بدنيّا هائلاً لنحت أعماله.
وتخبرنا روايات السيرة التي كُتبت عنهما أن ليوناردو كان ساحرا وأنيقا، بينما لم يكن لدى ميكيل انجيلو سوى القليل من الوقت للتباهي أو متابعة الموضة. وقد استخدم كلاهما أساليب مختلفة للحصول على عملاء مرموقين. وساعدت الكاريزما الشخصية لليوناردو في عرض أعماله على الرعاة الأثرياء كعائلة ميديتشي القويّة في فلورنسا، بينما كان الرعاة يثقون في اجتهاد ميكيل أنجيلو والتزامه، وهو ما بدا أن ليوناردو كان يفتقر إليه أحيانا.
كان ميكيل أنجيلو شخصا منعزلاً وميّالا للقتال وقاسيا وفوضويا ولا يثق في الناس بسهولة. وكان دافنشي دائما شخصا هادئا ولبقا ومرتّبا وودودا مع الجميع تقريبا. ويقال إنهما التقيا بضع مرّات، وفي إحداها طلب دافنشي من ميكيل أنجيلو شرحا لجزء من كتاب الكوميديا الإلهية لدانتي، إذ كان الأخير مرجعا معروفا في شرح أعمال الشاعر. وبدلا من الردّ على السؤال، انتقد ميكيل أنجيلو دافنشي على "محاولته الفاشلة" صبّ حصان برونزي تكريما لأهل ميلانو، في إشارة ضمنية الى أن دافنشي خدعهم وسرق أموالهم.
وقيل أيضا أنه عندما أنتهى ميكيل أنجيلو من نحت تمثال ديفيد أو داود، تشكّلت لجنة لتحديد المكان الذي يجب أن يوضع فيه التمثال. وكان دافنشي عضوا في تلك اللجنة. وقد اقترح وضع التمثال في المكان المخصّص له في البداية، أي في أعلى جدار الكاتدرائية، بينما كان ميكيل أنجيلو يريد وضعه أمام قصر فيكيو. وفي النهاية انتصرت وجهة نظر ميكيل أنجيلو. وقد اقترح دافنشي أيضا أن تُغطّى الأعضاء الخاصّة بالتمثال، وفعلا أُخذ بمقترحه واستمرّ الحال كذلك لفترة قصيرة من الزمن.
والاختلافات بين الاثنين تمتدّ أيضا الى وجهات نظرهما حول أيّ الأشكال الفنّية يعتبر أعلى من سائر الفنون. ليوناردو كان يعتقد أن الرسم هو أهمّ الأشكال الفنيّة بسبب التنوّع والحريّة التي يمنحهما للفنّان لتمثيل الأشياء، حتى تلك الغير مرئيّة. ونحن نرى تجسيدا لهذه الإمكانية في لوحة الموناليزا، فالاتساع المذهل للمنظر الطبيعي الفانتازي الذي رسمه ليوناردو في خلفية اللوحة لا يمكن أن يكون موجودا إلا في ذهن رسّام عظيم مثله.
من ناحية أخرى، كان ميكيل أنجيلو يعتبر النحت أبا لجميع الفنون. كان الفنّ بالنسبة له أكثر من مجرّد وسيلة لتحقيق الثروة أو الشهرة، بل هو بوّابة للتعبير عن رؤيته للجمال وتجسيدها. وكان يؤمن بفكرة أفلاطونية مفادها أن إنشاء التمثال يعني التحرّر من الحجر الصلب، أي أن الحجر بالنسبة له هو مادّة أو قناع يحمل الشكل. وكان يرى أن التمثال مكتمل بالفعل داخل كتلة الرخام حتى قبل أن يبدأ النحّات عمله، وأن كلّ ما عليه فعله هو إزالة الموادّ الزائدة عن الحاجة.
ومن أشهر أقواله: كلّ كتلة من الحجر بداخلها تمثال، ومهمّة النحّات هي اكتشافه. وقوله: يمكن للمنحوتة العظيمة أن تتدحرج إلى أسفل التلّ دون أن تنكسر. وقوله عن تمثال له يصوّر ملاكا صغيرا: رأيت الملاك في الرخام فنحتّه حتى أطلقت سراحه."
ختاما، كان كلّ من ليوناردو دافنشي وميكيل أنجيلو أستاذين في الفنّ وكانت بينهما أوجه شبه وأوجه اختلاف واضحة في أسلوبهما وفي مجال خبرتهما. لكن ما يزال العالم يحتفل بمساهمات الاثنين وإبداعاتهما المتميّزة في عالم الفنّ حتى يومنا هذا.
وقيل أيضا أنه عندما أنتهى ميكيل أنجيلو من نحت تمثال ديفيد أو داود، تشكّلت لجنة لتحديد المكان الذي يجب أن يوضع فيه التمثال. وكان دافنشي عضوا في تلك اللجنة. وقد اقترح وضع التمثال في المكان المخصّص له في البداية، أي في أعلى جدار الكاتدرائية، بينما كان ميكيل أنجيلو يريد وضعه أمام قصر فيكيو. وفي النهاية انتصرت وجهة نظر ميكيل أنجيلو. وقد اقترح دافنشي أيضا أن تُغطّى الأعضاء الخاصّة بالتمثال، وفعلا أُخذ بمقترحه واستمرّ الحال كذلك لفترة قصيرة من الزمن.
والاختلافات بين الاثنين تمتدّ أيضا الى وجهات نظرهما حول أيّ الأشكال الفنّية يعتبر أعلى من سائر الفنون. ليوناردو كان يعتقد أن الرسم هو أهمّ الأشكال الفنيّة بسبب التنوّع والحريّة التي يمنحهما للفنّان لتمثيل الأشياء، حتى تلك الغير مرئيّة. ونحن نرى تجسيدا لهذه الإمكانية في لوحة الموناليزا، فالاتساع المذهل للمنظر الطبيعي الفانتازي الذي رسمه ليوناردو في خلفية اللوحة لا يمكن أن يكون موجودا إلا في ذهن رسّام عظيم مثله.
من ناحية أخرى، كان ميكيل أنجيلو يعتبر النحت أبا لجميع الفنون. كان الفنّ بالنسبة له أكثر من مجرّد وسيلة لتحقيق الثروة أو الشهرة، بل هو بوّابة للتعبير عن رؤيته للجمال وتجسيدها. وكان يؤمن بفكرة أفلاطونية مفادها أن إنشاء التمثال يعني التحرّر من الحجر الصلب، أي أن الحجر بالنسبة له هو مادّة أو قناع يحمل الشكل. وكان يرى أن التمثال مكتمل بالفعل داخل كتلة الرخام حتى قبل أن يبدأ النحّات عمله، وأن كلّ ما عليه فعله هو إزالة الموادّ الزائدة عن الحاجة.
ومن أشهر أقواله: كلّ كتلة من الحجر بداخلها تمثال، ومهمّة النحّات هي اكتشافه. وقوله: يمكن للمنحوتة العظيمة أن تتدحرج إلى أسفل التلّ دون أن تنكسر. وقوله عن تمثال له يصوّر ملاكا صغيرا: رأيت الملاك في الرخام فنحتّه حتى أطلقت سراحه."
ختاما، كان كلّ من ليوناردو دافنشي وميكيل أنجيلو أستاذين في الفنّ وكانت بينهما أوجه شبه وأوجه اختلاف واضحة في أسلوبهما وفي مجال خبرتهما. لكن ما يزال العالم يحتفل بمساهمات الاثنين وإبداعاتهما المتميّزة في عالم الفنّ حتى يومنا هذا.
Credits
leonardoda-vinci.org
michelangelo.org
leonardoda-vinci.org
michelangelo.org