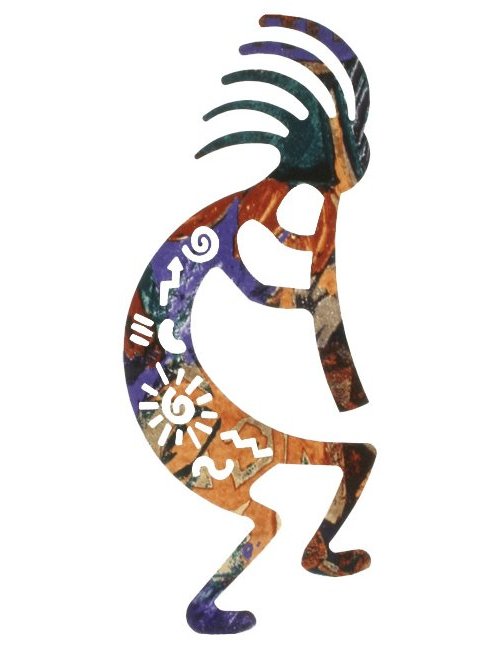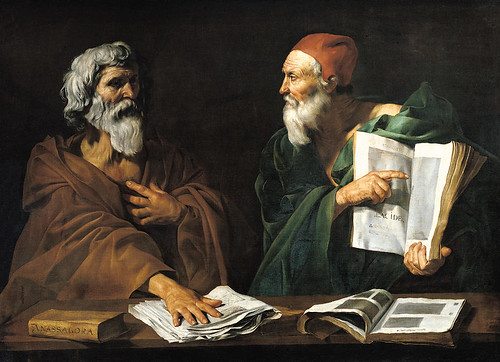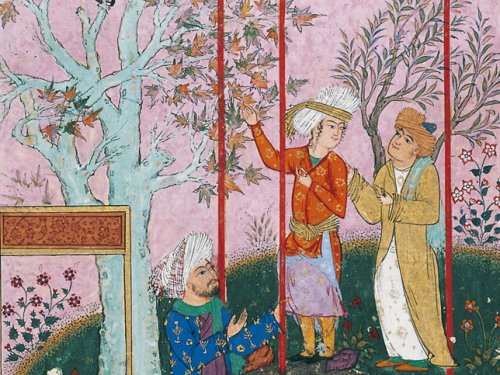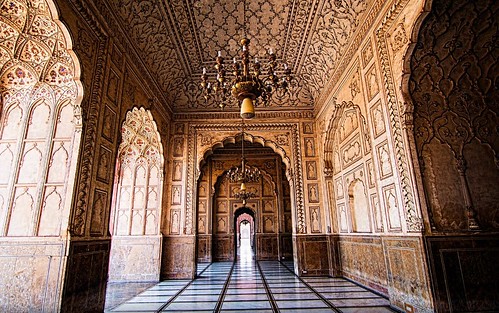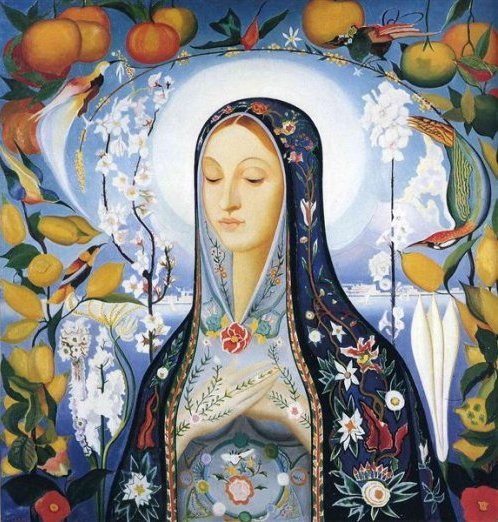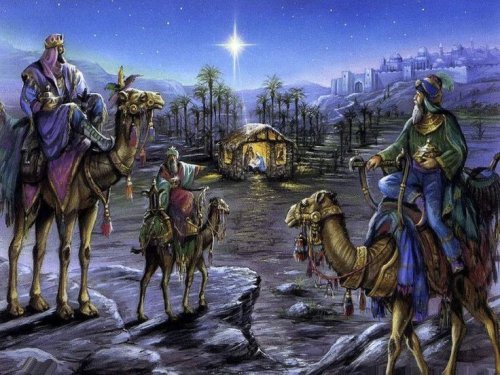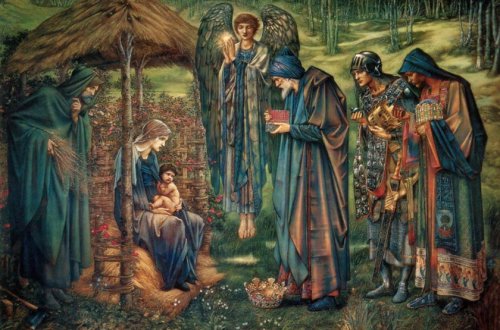ثمّة حكمة بوذية عمرها أكثر من مائتي عام تشرح بوضوح أهمّية النظر إلى السماء بانتظام. فطبقا للحكاية الشعبية، كان المعلّم والشاعر اليابانيّ ريوكان تايغو الذي عاش ما بين القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ناسكا سعيدا.
وقد تلقّى هذا الناسك دروسا في دير لعشر سنوات، ثم رفض الدين التقليديّ وقرّر أن يعيش حياة بسيطة قضاها في التأمّل وكتابة الشعر.
ومن وقت لآخر، كان يحتسي شرابا شعبيّا مع الفلاحين في الريف ويتقاسم طعامه المتقشّف مع الطيور والحيوانات في البرّية.
وفي الحقيقة لم يكن لدى ذلك الناسك ما يغري الآخرين بالسرقة. لكن في إحدى الليالي أتى إلى كوخه الجبليّ المنعزل لصّ كان يمنّي نفسه بالعثور على كنز.
لكن اللصّ لم يجد شيئا ذا قيمة، فشعر بالإحباط، الأمر الذي أحزنَ الناسك أيضا. ويقال أن الناسك تناول ملابسه وفراشه ودفع بها إلى اللصّ قائلا: لقد أتيتَ من مسافة بعيدة وتجشّمت عناء الطريق لكي تراني. وأرجوك أن تقبل منّي هذه الهديّة".
وأخذ اللصّ المذهول ملابس الناسك ومضى في سبيله. ثم تذكر القصّة أن الناسك أمضى بقيّة تلك الليلة عاريا، يحدّق في السماء ويتأمّل القمر الذي كان يلمع مثل جوهرة لا يمكن لأحد أن يسرقها على الرغم من أن الجميع يستمتعون بمرآها.
وكان المعلّم ريوكان ما يزال حزينا لأنه لم يستطع أن يعطي اللصّ أكثر الكنوز قيمةً. وكتب في مفكّرته قصيدة هايكو أصبحت الآن مشهورة ويشرح فيها تلك التجربة بقوله: اللصّ تركه خلفه، القمر عند حافّة النافذة".
هذه القصّة يرويها معلّمو البوذية ليذكّروا تلاميذهم أن معظم الناس مرتبطون بأشياء غير مهمّة في واقع الأمر. وكان ريوكان سيشارك اللصّ كنزه الأعظم لو أن الزائر الغريب رأى ذلك الكنز.
القمر في البوذية يرمز للتنوير. وكلّ منّا يمكن أن يصبح إنسانا منيرا وساطعا كقمر مكتمل في ليلة صافية. لكن أفضل ما في طبيعتنا تحجبه الغيوم، على حدّ تعبير الأستاذ الأكاديميّ كينيث كلارك.
فالارتباط والتعلّق بالأشياء وتشتيت الانتباه تمنعنا من إدراك أن لدينا ما نحتاجه بالفعل. وبحسب فلاسفة الزِّن فإن الوجود بحدّ ذاته كافٍ وليس هناك حاجة لأن نتطلّع إلى السلطة أو المال أو التجارب المثيرة التي لا تسبّب للإنسان سوى المعاناة. لكن بمقدورنا دائما أن نُمسك بالكنز الحقيقيّ؛ بالقمر المنير المخبّأ خلف غيوم ذواتنا، على حدّ تعبير كرافت.
ويشرح ذلك بقوله: هناك صورة صغيرة ودائرية للهلال رسمها بالحبر البسيط المعلّم والرسّام اليابانيّ من القرن التاسع عشر ناتنبو، ليبرهن على الإمكانيات اللامحدودة التي توفّرها الأشكال المألوفة وأشياء الحياة اليومية، سواءً كانت قمرا في السماء أو آنية في مطبخك.
كان ناتنبو رسّاما غزير الإنتاج. وقد تعلّم استخدام الرسم كوسيلة للتعبير عن المعاني التي تعجز عنها الكلمات. ورسم معظم لوحاته بعد أن تجاوز السبعين من عمره ووظّف فيها احد أعمق الرموز في البوذية، أي الدائرة. فهي فارغة لكنّها مكتملة تماما، ولانهائية لأنها تبدو بلا بداية ولا نهاية، مثل الكون.
إننا عندما نتواصل مع الكون الكلّيّ ومع الأشياء البسيطة من حولنا فإننا نصبح أغنياء. وامتلاك هذه الثروة متاح للجميع، حتى للناسك الفقير الذي يعيش في الجبال. وهذا هو السبب في آن ناتنبو تقش على لوحته بيتا من الشعر يقول فيه: إذا أردت القمر فهو هنا، تعال وأمسك به".
هناك كلمة تتردّد دائما على ألسنة المعلّمين الروحانيين وخبراء تطوير الذات وهي (Mindfulness)، وتعني الوعي باللحظة الراهنة. أي البحث عن المتع البسيطة في الحاضر.
فبدلا من أن نشغل أنفسنا بتأمين راتب اكبر أو منزل أوسع أو سيارة أفضل لكي نطمئنّ على المستقبل، يتعيّن علينا أن نتوقّف عن ذلك اللهاث قليلا كي نشمّ عبير زهرة أو نمارس رياضة مفيدة أو نزور صديقا لم نرَه منذ زمن أو نأخذ إجازة قصيرة أو نراقب نزول قطرات المطر على ارض جافّة أو نستمع إلى زقزقة العصافير في الصباح الباكر.
ومثل هذه الأشياء على بساطتها ومألوفيّتها يمكن أن تجلب للإنسان سعادة عظيمة. والكثيرون منا يضيّعون هذه المتع الصغيرة أثناء بحثهم عن سعادة اكبر قد تكون متوهّمة ويتعذّر بلوغها، كما تقول الكاتبة الأمريكية بيرل بك مؤلّفة رواية "الأرض الطيّبة".
إن الحياة عبارة عن سلسلة من اللحظات، والسعادة هي احتفال بالحياة وبكوننا أحياءً. وعندما تشعر بالامتنان لكلّ شيء منحك الله إيّاه فستبتعد عنك الأفكار السلبية كالغضب والإحباط والكراهية والقلق والخوف وما إلى ذلك.
ذات مرّة سُئل شيخ صوفيّ: ما الذي يجعل قلبك راضيا قنوعا؟ فقال: في كلّ صباح ارفع يديّ إلى الله لأقول له شكرا لك يا ربّي على كلّ شيء، فأنا لا اشتكي من شيء ولا انتظر شيئا".
إننا لن نجد الحياة إلا في اللحظة الراهنة. فأمس أصبح تاريخا والغد في علم الغيب واليوم منحة أو هديّة، وهذا هو السبب في أن اليوم يُسمّى الحاضر أو (The Present) في الانجليزية. وما لم نعش في الحاضر فإن الحياة ستفوتنا.
وقد تلقّى هذا الناسك دروسا في دير لعشر سنوات، ثم رفض الدين التقليديّ وقرّر أن يعيش حياة بسيطة قضاها في التأمّل وكتابة الشعر.
ومن وقت لآخر، كان يحتسي شرابا شعبيّا مع الفلاحين في الريف ويتقاسم طعامه المتقشّف مع الطيور والحيوانات في البرّية.
وفي الحقيقة لم يكن لدى ذلك الناسك ما يغري الآخرين بالسرقة. لكن في إحدى الليالي أتى إلى كوخه الجبليّ المنعزل لصّ كان يمنّي نفسه بالعثور على كنز.
لكن اللصّ لم يجد شيئا ذا قيمة، فشعر بالإحباط، الأمر الذي أحزنَ الناسك أيضا. ويقال أن الناسك تناول ملابسه وفراشه ودفع بها إلى اللصّ قائلا: لقد أتيتَ من مسافة بعيدة وتجشّمت عناء الطريق لكي تراني. وأرجوك أن تقبل منّي هذه الهديّة".
وأخذ اللصّ المذهول ملابس الناسك ومضى في سبيله. ثم تذكر القصّة أن الناسك أمضى بقيّة تلك الليلة عاريا، يحدّق في السماء ويتأمّل القمر الذي كان يلمع مثل جوهرة لا يمكن لأحد أن يسرقها على الرغم من أن الجميع يستمتعون بمرآها.
وكان المعلّم ريوكان ما يزال حزينا لأنه لم يستطع أن يعطي اللصّ أكثر الكنوز قيمةً. وكتب في مفكّرته قصيدة هايكو أصبحت الآن مشهورة ويشرح فيها تلك التجربة بقوله: اللصّ تركه خلفه، القمر عند حافّة النافذة".
هذه القصّة يرويها معلّمو البوذية ليذكّروا تلاميذهم أن معظم الناس مرتبطون بأشياء غير مهمّة في واقع الأمر. وكان ريوكان سيشارك اللصّ كنزه الأعظم لو أن الزائر الغريب رأى ذلك الكنز.
القمر في البوذية يرمز للتنوير. وكلّ منّا يمكن أن يصبح إنسانا منيرا وساطعا كقمر مكتمل في ليلة صافية. لكن أفضل ما في طبيعتنا تحجبه الغيوم، على حدّ تعبير الأستاذ الأكاديميّ كينيث كلارك.
فالارتباط والتعلّق بالأشياء وتشتيت الانتباه تمنعنا من إدراك أن لدينا ما نحتاجه بالفعل. وبحسب فلاسفة الزِّن فإن الوجود بحدّ ذاته كافٍ وليس هناك حاجة لأن نتطلّع إلى السلطة أو المال أو التجارب المثيرة التي لا تسبّب للإنسان سوى المعاناة. لكن بمقدورنا دائما أن نُمسك بالكنز الحقيقيّ؛ بالقمر المنير المخبّأ خلف غيوم ذواتنا، على حدّ تعبير كرافت.
ويشرح ذلك بقوله: هناك صورة صغيرة ودائرية للهلال رسمها بالحبر البسيط المعلّم والرسّام اليابانيّ من القرن التاسع عشر ناتنبو، ليبرهن على الإمكانيات اللامحدودة التي توفّرها الأشكال المألوفة وأشياء الحياة اليومية، سواءً كانت قمرا في السماء أو آنية في مطبخك.
كان ناتنبو رسّاما غزير الإنتاج. وقد تعلّم استخدام الرسم كوسيلة للتعبير عن المعاني التي تعجز عنها الكلمات. ورسم معظم لوحاته بعد أن تجاوز السبعين من عمره ووظّف فيها احد أعمق الرموز في البوذية، أي الدائرة. فهي فارغة لكنّها مكتملة تماما، ولانهائية لأنها تبدو بلا بداية ولا نهاية، مثل الكون.
إننا عندما نتواصل مع الكون الكلّيّ ومع الأشياء البسيطة من حولنا فإننا نصبح أغنياء. وامتلاك هذه الثروة متاح للجميع، حتى للناسك الفقير الذي يعيش في الجبال. وهذا هو السبب في آن ناتنبو تقش على لوحته بيتا من الشعر يقول فيه: إذا أردت القمر فهو هنا، تعال وأمسك به".
هناك كلمة تتردّد دائما على ألسنة المعلّمين الروحانيين وخبراء تطوير الذات وهي (Mindfulness)، وتعني الوعي باللحظة الراهنة. أي البحث عن المتع البسيطة في الحاضر.
فبدلا من أن نشغل أنفسنا بتأمين راتب اكبر أو منزل أوسع أو سيارة أفضل لكي نطمئنّ على المستقبل، يتعيّن علينا أن نتوقّف عن ذلك اللهاث قليلا كي نشمّ عبير زهرة أو نمارس رياضة مفيدة أو نزور صديقا لم نرَه منذ زمن أو نأخذ إجازة قصيرة أو نراقب نزول قطرات المطر على ارض جافّة أو نستمع إلى زقزقة العصافير في الصباح الباكر.
ومثل هذه الأشياء على بساطتها ومألوفيّتها يمكن أن تجلب للإنسان سعادة عظيمة. والكثيرون منا يضيّعون هذه المتع الصغيرة أثناء بحثهم عن سعادة اكبر قد تكون متوهّمة ويتعذّر بلوغها، كما تقول الكاتبة الأمريكية بيرل بك مؤلّفة رواية "الأرض الطيّبة".
إن الحياة عبارة عن سلسلة من اللحظات، والسعادة هي احتفال بالحياة وبكوننا أحياءً. وعندما تشعر بالامتنان لكلّ شيء منحك الله إيّاه فستبتعد عنك الأفكار السلبية كالغضب والإحباط والكراهية والقلق والخوف وما إلى ذلك.
ذات مرّة سُئل شيخ صوفيّ: ما الذي يجعل قلبك راضيا قنوعا؟ فقال: في كلّ صباح ارفع يديّ إلى الله لأقول له شكرا لك يا ربّي على كلّ شيء، فأنا لا اشتكي من شيء ولا انتظر شيئا".
إننا لن نجد الحياة إلا في اللحظة الراهنة. فأمس أصبح تاريخا والغد في علم الغيب واليوم منحة أو هديّة، وهذا هو السبب في أن اليوم يُسمّى الحاضر أو (The Present) في الانجليزية. وما لم نعش في الحاضر فإن الحياة ستفوتنا.
Credits
qz.com
qz.com