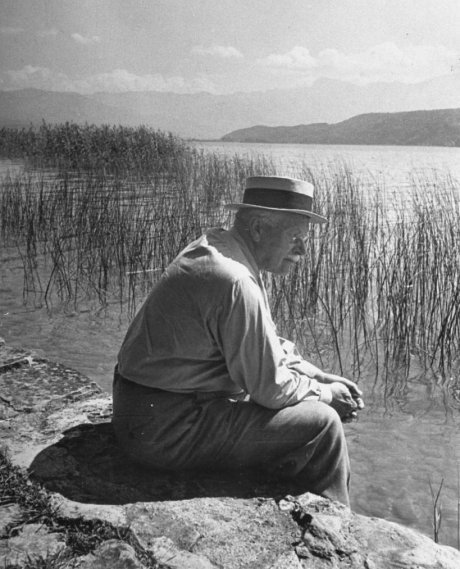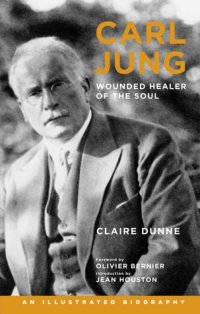يذهب بعض النقّاد الى أن اللوحة التي فوق هي أشهر لوحة في تاريخ الفن رُسمت لقطط. وهي للفنّان الأمريكي كارل كاهلر الذي رسمها عام ١٨٩١ وضمّنها ٤٢ قطّة معظمها من سلالة أنغورا التركية. وجاء رسم اللوحة بطلب من مليونيرة من سان فرانسيسكو كانت تُلقّب بملكة القطط، وأرادت من خلالها تكريم أصدقائها من القطط التي كانت تعيش معها.
ولأجل إنجاز هذه المهمّة، أقام الرسّام في قصر المرأة الذي كان يضمّ 300 قطّة وعددا من الكلاب الحائزة على جوائز وخيولا وماشية وطيورا مختلفة. وأمضى ثلاث سنوات وسط هذه المجموعة من الحيوانات والطيور بغرض رسم القطط والتعرّف على شخصياتها الفريدة.
وتظهر القطط في اللوحة بأمزجة وأنشطة مختلفة، فبعضها يستريح وبعضها يلعب وبعضها الآخر متجمّع حول فراشة. وفي منتصف اللوحة يظهر "سلطان"، وهو اسم قطّ جميل وضخم له عينان خضراوان وفرو أبيض وأسود، وهو يحدّق في الناظر. ويُقال إن المليونيرة اشترت هذا القطّ من باريس بمبلغ ثلاثة آلاف دولار.
بعد الشهرة الكبيرة التي اكتسبتها هذه اللوحة، تخصّص كاهلر، المولود في النمسا عام ١٨٥٦، برسم القطط طوال حياته. وقد دفعت له المرأة خمسة آلاف دولار أمريكي ثمناً للوحة، أي حوالي مائتي ألف دولار بسعر هذه الأيّام. وتردّد أنها تركت حوالي نصف مليون دولار في وصيّتها لرعاية القطط.
كثيرا ما يقال على سبيل الدعابة أن لهذه اللوحة "تسع أرواح"، فقد نجت من الزلزال الكبير الذي ضرب سان فرانسيسكو عام ١٩٠٦ وتسبّب في تدمير المدينة وفي مقتل الرسّام نفسه عن عمر لا يتجاوز الخمسين عاما. وهناك سبب آخر لهذا الوصف الطريف يتمثّل في كثرة الأشخاص الذين تعاقبوا على امتلاك اللوحة بعد موت صاحبتها الأصلية.
كارل كاهلر لم يكن أوّل ولا آخر فنّان يحبّ القطط، فقائمة عشّاق القطط من الفنّانين طويلة، من كليمت وماتيس وبيكاسو الى دالي واوكيف ورينوار وغيرهم. وربّما يعود سبب هذه الشعبية الكبيرة للقطط إلى أن كلّ قطّة هي بحدّ ذاتها عمل فنّي جميل ونابض بالحياة. وكلّ من يعيش مع قطّة يعلم أن كلّ حركة لها هي تعبير رشيق عن فطرتها الفنّية. لذا تتمتّع القطط بتلك الجاذبية الخفيّة التي تنسجم تماما مع طبيعتها الغامضة. ولا عجب أن العديد من الفنّانين والكتّاب البارزين يعتبرون القطط وسيطاً عابرا لأبعاد وعوالم متنوّعة.
وأكثر من هذا، فإن بعض الثقافات أدرجت القطط ضمن آلهتها. وأشهرها بالطبع الإلهة المصرية القديمة المسمّاة "باستت". وهناك العديد من الرسومات والنقوش الفرعونية على التوابيت والجدران تصوّر قططا أو آلهة برؤوس قطط. كما توجد مقابر مزيّنة لدفن القطط، ما يدلّ على ان القطط في مصر القديمة كانت تُرفع فوق مستوى المخلوقات الأخرى، وعند وفاتها كانت تُحنّط وتُدفن لتنتقل هي أيضا إلى الدار الآخرة.
وفي مصر أيضا، كان إيذاء قطّة يُعتبَر خيانة. وفي ذروة شعبية الإلهة القطّة باستت، كان قتل قطّة، حتى عن طريق الخطأ، جرماً يعاقَب عليه بالإعدام! وبصفتها "رسولة وخادمة للإلهة"، كانت القطط تُصوّر كثيرا في الفنّ المصري. ومن أمثلة ذلك تمثال قطّة من البرونز المصبوب والمزيّن بالمجوهرات موجود في المتحف البريطاني.
وعلى الرغم من أن اليابان لم تشهد عمليات مطاردة للساحرات كتلك التي حدثت في أوروبّا في العصور الوسطى، إلا أنها تبنّت وجهتي نظر متباينتين عن القطط. فبعض الأساطير اليابانية تصوّرها كأرواح مسالمة، ولكن البعض الآخر يرى فيها كائنات شيطانية. وإحدى تلك الأساطير تحكي قصّة رجل قتل خادمه، ثم أسرّت والدة القاتل بأحزانها لقطّة قبل أن تنتحر. وهنا تلعق القطّة دم الأم وتصبح روحا شرّيرة تطارد ابنها القاتل.
ومن المثير للاهتمام أن نفس الصفات التي أدّت إلى تدجين القطط، وأحيانا تأليهها، كانت هي أيضا التي تسبّبت في شيطنتها. ومع هذه التناقضات الكبيرة في تمثيلاتها، من السهل معرفة سبب استمرار القطط في جذب انتباهنا وتخليدها في الفن.
مثلا، تركّز لوحة "طبيعة صامتة مع قطّة وجراد بحر" لبابلو بيكاسو على طبيعة القطّة المفترسة. بينما تقدّم لوحة "القطّ الأزرق" لآندي وارهول جانبها المرح. أما عن استخدام القطّة كرمز، فقد اشتهر ألكسندر شتاينلين بملصقه المشهور الذي رسمه لملهى "القطّ الأسود". وقيل ان اسم الملهى الباريسي مستوحى من قصّة لإدغار آلان بو بنفس الاسم.
وجود القطط حول الفنّانين هو بحدّ ذاته عنصر إلهام، حيث رسم رينوار وميري كاسات القطط الصغيرة، وربط مانيه الحداثة بالقط الأسود، وأعجب بيكاسو، عاشق الكلاب، بوحشية القطط البرّية. والفنّانون يقدّرون عادةً القطط لأنها تتطلّب اهتماما أقلّ وتتميّز باستقلالية أكبر. وأحيانا قد يكون استوديو الفنّان مكانا منعزلا ووجود قطّ فيه يُضفي عليه حيوية ما. ومثال هذا وارهول الذي بدأ حياته في شقّة مع والدته بصحبة 25 قطّة، وهو ما ألهمه رسم عدد من المطبوعات الحجرية الملوّنة لقطط.
كان بول كلي أيضا يربّي عددا من القطط التي أثّرت بشكل مباشر في أعماله. وكانت قطّته الأولى نموذجا للوحاته في عشرينات القرن الماضي. وقد رسم لوحة بعنوان "القطّ والطائر" توحي بأن من رسمها طفل، إذ كان كلي يعتقد أن الأطفال أقرب إلى مصدر الإبداع. وهناك أيضا الياباني تسوغوهارو فوجيتا الذي تظهر القطط كثيرا في فنّه. ومن أسباب حبّ اليابان الحديثة للقطط، أن مدنها كانت وما تزال موبوءة بالفئران، ومعروف أنه لا يخيف الفئران أفضل من القطط.
هذه مجرّد أمثلة قليلة عن الفنّانين الذين ألهمتهم قططهم بعض أعمالهم.
لكن لماذا يستمرّ هذا الانبهار والاهتمام بالقطط حتى اليوم كما يتّضح في الثقافة الشعبية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي وما سرّ جاذبيتها؟
يشير البعض الى أن مضاهاة وجوه القطط لوجوه الأطفال الصغار تثير حاجة بيولوجية فينا للرعاية والاحتضان. كما انه بسبب وجود القطط في الأساطير وكونها جزءا من بيئة سرد القصص الجماعية، فإننا ننجذب إلى تمثيلاتها العديدة. ومثل أسلافنا القدماء، فإن وجود القطّة كعضو ثمين في بيوتنا يدفعنا لتقديرها وتخليدها.
dornsife.usc.edu
Artnet.com