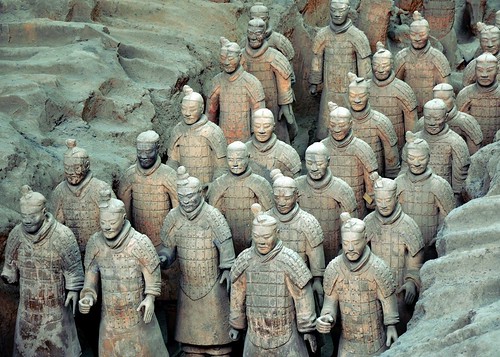طوال حياة همنغوي، تعرّض للإيذاء والصدمات وشاهد الناس من حوله وهم يقتلون أنفسهم ويعذّبون بعضهم بعضا. ولم يكن مستغربا أن ينقل الكثير مما رآه في الحروب والصراعات التي غطّاها كصحفي الى رواياته.
ومع مرور الوقت أصبح الكاتب مهجوسا بالموت والانتحار، وجرّب أيضا الألم المزمن وإدمان الكحول الذي لم يتمكّن من السيطرة عليه أبدا. كما عانى من اضطراب ما بعد الصدمة بعد تحطّم الطائرة التي كان على متنها في أفريقيا وإصابته بكسر في الجمجمة مع إصابات أخرى.
كان همنغوي كاتبا عظيما، لكن لم تُتح له الفرصة ليكون سعيدا أو ليعيش حياة طبيعية. نوع الألم الذي عاشه كان يحتاج لأجيال حتى يُشفى منه أو تخفّ آثاره. وكان سلوك همنغوي خلال سنواته الأخيرة مشابها لسلوك والده قبل أن يقتل هو الآخر نفسه.
قيل إن والده كان يعاني من داء الصبغات الدموية الوراثي، حيث يؤدّي تراكم الحديد بشكل مفرط في الأنسجة إلى التدهور العقلي والجسدي. وقد أكّدت السجلات الطبّية أن همنغوي الابن قد شُخّصت إصابته بنفس المرض في أوائل عام 1961.
ويقال أيضا أن شقيقه وشقيقته انتحرا لنفس السبب. وقد ازدادت صحّة همنغوي سوءا بسبب شكواه الدائمة من مضايقات المباحث الفيدرالية ومراقبتهم له باستمرار.
كان همنغوي يلعب لعبة الحياة طوال فترة وجوده. لكنه لم يحصل على حياة سعيدة ومستقرّة. لم يفز وأسقط معه الكثير من الناس. وليس من الانصاف أن يلام على كل ما حدث له في حياته. ولنتذكّر دائما أن هذه الحياة ليست عادلة.
هذا التدقيق في تفاصيل الواقع من أجل متابعة شيء لا يمكننا رؤيته مباشرة، لكن بالإمكان متابعة آثاره. وفي نفس الوقت إدراك أننا يمكن أن نكون مخطئين دائما، وبالتالي مستعدّين في أيّ لحظة لتغيير الاتجاه إذا ظهر مسار جديد. ولكن مع علمنا أيضا أنه إذا كنّا جيدين بما يكفي، فسنقوم بذلك بشكل صحيح وسنجد ما نسعى إليه. وهذه هي طبيعة العلم.
-كارلو روڤيللي
ويضيف: البراءة التي في أعين جميع الحيوانات كانت تتطلّع إليّ في تلك اللحظة طالبةً العون. كان سلوك ذلك الثور بمثابة صرخة احتجاج واستغاثة من أجل العدالة. وفي مكان ما في أعماقي، أدركت فجأة أنه كان يخاطبني بنفس الطريقة التي نخاطب بها الله في الصلاة.
كأنّه كان يقول: لا أريد أن أقاتلك، من فضلك اتركني، لأنني لم أفعل شيئا. اقتلني إذا أردت، لكنّي لا أريد أن أقاتلك. كنت أقرأ ذلك في عينيه، وشعرت بأنّني أسوأ وأتعس مخلوق على وجه الأرض".
ومن تلك اللحظة قرّر مونيرو اعتزال عمله كمصارع للثيران الى الأبد. ثم توقّف عن أكل كافّة أنواع اللحوم وأصبح شخصا نباتيّا.
نسبُ نفرتيتي غير معروف تماما. لكن اسمها مصري ويعني: لقد أتت امرأة جميلة". وبعض علماء المصريات يعتقدون أنها كانت أميرة من سوريا. لكن هناك أيضا أدلّة تشير إلى أنها كانت الابنة المصرية المولد لمسؤول في بلاط أخناتون.
وتشتهر نفرتيتي بتمثالها النصفي الملوّن والمصنوع من الحجر الرملي، الذي يعود الى عام 1345 قبل الميلاد. وقد اكتُشف التمثال عام 1913 في بلدة تلّ العمارنة على يد فريق آثاري بقيادة عالم الآثار الألماني لودفيك بوركهارت.
وأصبح التمثال منذ اكتشافه أحد أكثر الأعمال الفنّية استنساخا من مصر القديمة. وإلى اليوم ما يزال واحدا من أجمل الصور الأنثوية من العالم القديم. النحّاتون المصريون نادرا ما كانوا يعبّرون عن أيّ انفعال في وجوه أعمالهم الفنّية. لكن هذا الوجه يُعدّ تجسيدا للصفاء ورباطة الجأش. والمُشاهد لا ينظر إلى نموذج مثالي، بل إلى صورة منمّقة لشخص ذي مظهر ملفت وشخصية قويّة.
وبحسب بوركهارت، تتميّز الشخصية المنحوتة برقبة نحيلة ووجه متناسق وغطاء رأس أسطواني أزرق. وقد صُمّمت عضلات القفا وجوانب الرقبة بشكل دقيق للغاية، لدرجة أن المرء يتخيّل رؤيتها وهي تنثني تحت الجلد الرقيق والألوان الطبيعية."
كان الفريق الألماني قد اتفق مع الحكومة المصرية على تقاسم القطع الأثرية، لذلك شُحن التمثال النصفيّ كجزء من حصّة ألمانيا.
وفي عام 1922، اكتشف عالم المصريات البريطاني هوارد كارتر مقبرة الملك توت. وتبع ذلك موجة من الاهتمام الدولي، وسرعان ما أصبحت صورة القناع الجنائزي المصنوع من الذهب الخالص لتوت رمزا عالميا للجمال والثروة والقوّة. وبعد مرور عام، عُرض تمثال نفرتيتي النصفي في برلين، في مواجهة توت عنخ آمون "الإنغليزي" لكي تستعيد ألمانيا لتمثالها بعضا من بريقه القديم.
على جدران المقابر والمعابد التي شُيّدت في عهد أخناتون، كثيرا ما تُصوَّر نفرتيتي إلى جانب زوجها اخناتون. وفي كثير من الحالات تظهر في مواقع القوّة والسلطة وهي تترّأس طقوس عبادة آتون أو تقود عربة أو تهاجم عدوّا.
قبل عام 2012، كان يُعتقد أن نفرتيتي اختفت من السجل التاريخي في العام الثاني عشر من حكم أخناتون الذي دام 17 عاما. وقيل إنها ربّما تكون قد ماتت بسبب إصابتها بالطاعون أو لسبب آخر. لكن في عام 2012، اكتُشف نقش من العام السادس عشر من حكم أخناتون يحمل اسم نفرتيتي ويثبت أنها كانت ما تزال على قيد الحياة. غير أن ظروف وفاتها لا تزال مجهولة وكذلك مكان قبرها.
طوال الاضطرابات التي شهدها القرن العشرين، ظلّ تمثال نفرتيتي النصفي في أيدي الألمان. وكان هتلر يحبّ التمثال كثيرا، ونُقل عنه قوله: لن أتخلّى أبدا عن رأس الملكة". وفيما بعد أخفى الألمان التمثال في منجم للملح لإبعاده عن قنابل الحلفاء.
Credits
hemingwayhome.com
smb.museum/en
hemingwayhome.com
smb.museum/en