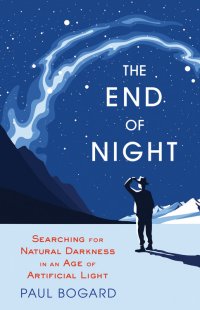ولم يكن من المستغرب أن يعود الزوّار الأوروبيون القلائل الذين رأوا المكان بالفعل قبل تدميره بروايات مليئة بالعجائب. وقد تفوّق الرهبان والرحّالة في العصور الوسطى على بعضهم البعض في سرد القصص التي تحكي عن جمال القصر والسلطة الهائلة التي كان يتمتّع بها "الخان العظيم".
بُني قصر يوانمينغيوان، ومعناه بالصينية حديقة الإشراق، على مراحل مختلفة بدءا من أوائل القرن الثامن عشر وحتى تدميره. وكان في البداية ملاذا خلّابا للأباطرة الذين رغبوا في الهرب من حرارة المدينة المحرّمة والالتزامات الرسمية في بيجين.
كانت الحديقة جنّة على الأرض لأباطرة تشينغ. كانت جميلة، فخمة، ومن صُنْعهم بالكامل وليست إرثا من السلالات السابقة. وقد صُمّمت المناظر الطبيعية لتشبه مشاهد من منطقة وادي اليانغتسي السفلي التي برز منها شعراء ورسّامون وأدباء صينيون مشهورون.
في القرن الثالث عشر تمكّن التجّار والمبشّرون الأوروبيون من السفر إلى الصين. وكان قصر "الخان العظيم" محطّ اهتمام رواياتهم عن ذلك البلد. والوصف الأكثر شهرة له جاء على لسان ماركو بولو الذي وصل إلى بيجين عام 1266 وقضى هناك حوالي 24 عاما.
وقد ذكر ماركو بولو أن قصر الإمبراطور ليس مجرّد مبنى واحد، بل مجمّع ضخم تبلغ مساحته حوالي أربعة أميال، ويضمّ بداخله العديد من القصور الرائعة الأخرى، وساحة مسيّجة يعيش فيها الخان مع عائلته. وهناك تلّ اصطناعي مزروع بالأشجار وبحيرة اصطناعية تعبرها جسور. ويمتلئ جزء كبير من المجمّع بالطيور والحيوانات البرّية، بحيث يتمكّن الإمبراطور من مطاردة الطرائد متى شاء دون مغادرة القصر أبدا. وفي وسط المبنى جرّة كبيرة يمكن للزوّار الشرب منها، وهناك مجموعة من تماثيل الطاووس بالإضافة الى أسد أليف يتجوّل بين الصالات.
كما يذكر ماركو بولو أن أعمدة القصر الأربعة والعشرين صُنعت من الذهب، بينما نُحتت جرّة الشرب من أحجار ثمينة تجاوزَ ثمنها قيمة أربع مدن عظيمة، وكان ثمن كلّ لؤلؤة تزيّن معاطف رجال الحاشية حوالي خمسة عشر ألف فلورين.
كانت الوفرة والجمال والثراء تعبيرات عن قوّة الإمبراطور الهائلة. وأمام عرشه، كان الزوّار يصمتون ثم يسجدون، مُؤدّين "الكوتو"، أي الركوع ثلاث مرّات والضرب مثلها على الرأس، كما ينصّ بروتوكول البلاط. كان عدد زوّار الخان من الأوروبيين قليلا، ولم يكن لديهم سوى سلوكهم الحسن لدعم مطالبهم المتواضعة بالتجارة والحقّ في التبشير بالإنجيل.
كان ماركو بولو يلقّب بـ"المليون" لميله الى المبالغة. ولكن سواءً كانت شهاداته صادقة أم لا، كانت هناك حاجة لسرد الكثير من العجائب إذا ما أُريد للقصص أن تجد جمهورا.
المبشّرون اليسوعيون في الصين اتّبعوا استراتيجية هرمية لتحويل أهل البلاد الى المسيحية. فبعد أن يُقنعوا البلاط الإمبراطوري باعتناق دينهم في البداية، كانوا يأملون لاحقا في تحويل البلاد كلّها الى الدين المسيحي. ولتحقيق هذا الهدف، قدّموا للإمبراطور نماذج متنوّعة من التكنولوجيا والفنون الأوروبية وعرضوا خدماتهم كرسّامين ورسّامي خرائط وعلماء فلك وصانعي ساعات وحتى صانعي مدافع.
وقد شكّلت رسائل البعثة اليسوعية العائدة إلى فرنسا والمنشورة في باريس في القرنين السابع عشر والثامن عشر، المصدر الأكثر موثوقيةً للمعلومات عن الصين. كانت تلك الرسائل تُقرأ على نطاق واسع، خاصّة من قِبل المدافعين عن الامتيازات الملكية في إنغلترا وفي فرنسا. وأصبحت الصين بالنسبة لفلاسفة مثل فولتير نموذجا للحكم الرشيد والنظام الاجتماعي.
وسمح تواجد بعض اليسوعيين في قصر الخان العظيم بوضع وصف شامل إلى حدّ ما للقصور والحدائق. وأشهر تلك الاوصاف يرد في رسالة كتبها الفرنسي جان دينيس أتيريه عام 1745 عندما كان يخدم كرسّام في بلاط الامبراطور.
وقد أوضح أتيريه أن الإمبراطور استلهم لتصميم الحديقة، ولكي تظهر بجمال خاص، معالم من جميع أنحاء الصين والعالم، منها معابد من منغوليا والتبت، وقرية ومشهد لنهر من هونان، وحدائق من سوتشو وهانغتشو، ومجموعة من الأبنية على الطراز الأوروبّي. بل إن القصر كان به نسخة طبق الأصل من شارع صيني عادي مليء بالمتاجر والأكشاك والباعة المتجوّلين والزبائن والمتسوّلين. وكان الإمبراطور يتجوّل في تلك الأرجاء كما يحلو له، وكانت نساؤه يعقدن صفقات مع الخصيان الذين يلعبون دور البائعين.
لكن أكثر ما كان يلفت الانتباه الفوضى الجميلة و"عدم التماثل" اللذان سيطرا على تصميم المكان. فلم تكن المسارات والجسور العابرة فوق البحيرات مستقيمة بل متعرّجة، ولم تكن الأبواب والنوافذ مربّعة الشكل بل دائرية أو بيضاوية أو على شكل أزهار أو طيور أو أسماك. ورغم أن هذا الوصف قد يبدو ساذجا، إلا أن أتيريه أقرّ بأنه "عندما تراه بنفسك، ستُفكّر بطريقة مختلفة وستبدأ بالإعجاب بالفنّ الذي صُمّم به هذا التباين".
كانت حديقة القصر، بتنوّعها وشمولها، تمثّل كلّ ما هو موجود: الماضي والمستقبل والمواقع الغريبة والنباتات والحيوانات المذهلة والجبال الشاهقة والمحيطات والريف والمدينة. وكان الإمبراطور هو الحاكم الأوحد لهذا الكون البديع والشخص الذي جُمعت له كلّ هذه التسلية. ولأن كلّ شيء كان مرتّبا بتناغم وسلام، كانت الحديقة دليلا واضحا على فضائل حكمه. ومن منظور التصنيفات الجمالية التي كانت شائعة في القرن الثامن عشر، كان كلّ هذا مثيرا للفضول.
ويذكر أتيريه أن هناك خصوبة لا مثيل لها في روح الصينيين. في الواقع "أميل إلى الاعتقاد بأننا فقراء وعقيمون مقارنةً بهم". في حقبة سابقة، كانت هذه الخصوبة دليلاً على الفردوس. وكانت الفردوس أيضا حديقة يتجدّد فيها كلّ شيء باستمرار ودون عناء. وفي حقبة تالية، أصبحت هذه الخصوبة نفسها دليلاً على إنتاجية التربة الصينية وثروات الأسواق الصينية التي كانت تنتظر استغلالها من قبل التجّار الأوروبيين.
وتمشيّا مع موضة الطراز الصيني، ساهم أتيريه في إلهام إنشاء حدائق بنفس الطراز في جميع أنحاء القارّة. فبعد سنوات قليلة فقط من نشر مذكّراته، بنى فريدريك العظيم منزلا صينيّا في سان سوسيس وشيّدت كاترين العظيمة قصرا صينيا في أورانينباوم وبنى أدولف فريدريك ملك السويد قصرا صينيا في دروتنينغهولم. وفي عام 1761، شيّد المهندس المعماري ويليام تشيمبرز معبدا يبلغ ارتفاعه خمسين مترا في حدائق كيو، بالإضافة إلى "بيت كونفوشيوس".
كان تشيمبرز قد زار الصين من قبل. ففي شبابه، زار غوانتسو مرّتين في أربعينات القرن الثامن عشر على متن سفن تابعة لشركة الهند الشرقية السويدية. وقد درس هناك العمارة الصينية وفنون الحدائق. وفور عودته إلى أوروبّا، نشر عام ١٧٥٧ كتيّبا بعنوان "فنّ تصميم الحدائق عند الصينيين".
وأوضح تشيمبرز أن هناك ثلاثة أنواع مختلفة من المشاهد في الحدائق الصينية: المبهج، والمرعب، والساحر". وفي حين أن المبهج والساحر يتوافقان مع تصنيف اليسوعيين، إلا أن تركيزه على المرعب كان أمرا جديدا تماما. وقد أصرّ تشيمبرز على أن هذه المشاهد المروّعة كانت تتضمّن أشجارا مشوّهة مزّقتها العواصف وصخورا متداعية وشلالات جارفة ومبانٍ التهمت النيران نصفها. وصُمّمت هذه المشاهد لاستثارة المشاعر المتسامية.
وقد عاد تشيمبرز ثانية إلى حديقة الرعب تلك واستخدم قصر يوانمينغيوان كمثال توضيحي. وبعد وصفه للمتع التي تثيرها مسارات الحديقة المتعرّجة العديدة ومناظرها الساحرة، انتقل إلى "مشاهد الرعب": غابات كئيبة، ووديان عميقة لا تصلها الشمس، وصخور قاحلة، وكهوف مظلمة، وشلالات هادرة تتدفّق من الجبال في جميع الأرجاء".
وفي البساتين "كانت ترفرف الخفافيش والبوم وكلّ طائر جارح وتعوي الذئاب والنمور والضباع في الغابات وتتجوّل الحيوانات شبه الجائعة في السهول وتُرى المشانق والصلبان والعجلات وجميع أدوات التعذيب. وفي أكثر أركان الغابة كآبة، حيث الطرق وعرة ومليئة بالأعشاب، وحيث يحمل كلّ شيء علامات هجرة السكّان، توجد معابد مكرَّسة لملك الانتقام، وكهوف عميقة في الصخور، ومنحدرات تقود إلى مساكن تحت الأرض مُغطّاة بالأغصان والشجيرات العالقة".
بالطبع، كان وصف تشيمبرز الغريب لـ"حديقة الرعب" هدفا سهلا للسخرية. ومع ذلك، لم يكن من السهل كبح الحساسية التي كان وصف تشيمبرز تعبيرا عنها. فبالنسبة للكتّاب الرومانسيين في مطلع القرن التاسع عشر، كانت عجائب الشرق مصدرا لأحلام اليقظة الغريبة، وكان قصر الإمبراطور الصيني موضوعا مفضّلا.
في أكتوبر 1797، تناول الشاعر الإنغليزي سامويل تيلر كولريدج جرعة صغيرة من الأفيون ثم قرأ صفحات من حكايات الرحّالة الى الصين في العصور الوسطى، قبل ان يغالبه النعاس. وعندما استيقظ كتب قصيدة تصف جنّة صينية سامية ألهمته الشوق والرهبة:
"في زانادو أصدر قبلاي خان
قراراً ببناء قبّة ابتهاج فخمة
حيث جرى النهر المقدَّس "ألف"
عبر كهوف لا يستطيع إنسان إدراك مداها
أسفل إلى بحرٍ لا تطلع عليه شمس
لذا أُحيطت عشرةُ أميالٍ
من الأرض الخصبة بأسوار وأبراج
ووُجدت هناك حدائقُ زاهرة بجداولَ مُتعرِّجة
حيث أزهر كثير من شجر البخور
هنا كانت غابات قديمة كالتِّلال
تحتضن بقعاً خضراءَ مشمسة".
من الواضح أن كولريدج كان يتحرّك في نفس المجال الشعري الذي تحرّك فيه تشيمبرز. فكهوف كولريدج التي "لا يستطيع إنسان إدراك مداها" ليست بعيدة كثيرا عن "كهوف تشيمبرز العميقة في الصخور". كما لم يبتعد هذا كثيرا عن الرواية التي قدّمها ماركو بولو نفسه ذات مرّة. وما رآه كولريدج في حلمه هو قصر قبلاي خان الذي زاره بولو.
سياسيّا، يمكن قراءة قصيدة "قبلاي خان" على أنها تخلٍّ عمّا يُسمّى بـ "عبء الرجل الأبيض" ودعوة للمستعمرين والمستعمَرين لتبادل الأماكن. وعلى النقيض من ذلك، لم يكن تشيمبرز سريعا في التخلّي عن نفسه. فقد أشاد بالصينيين، ليس فقط لرعبهم، ولكن أيضا لبهجة حدائقهم.
في أغسطس 1793، وصل وفد ديبلوماسي بريطاني بقيادة جورج ماكارتني إلى بيجين بهدف فتح السوق الصينية الضخمة لتجارة السلع البريطانية الصنع. وعند وصولهم إلى القصر الإمبراطوري، متوقّعين بوضوح "تجربة سامية"، شعر الدبلوماسيون بخيبة أمل قويّة. وقال ماكارتني: ما رأيناه لا يرقى إلى مستوى الأوصاف الخيالية التي دسّها لنا الأب أتيريه والسير ويليام تشيمبرز على أنها حقائق".
وقال شخص آخر في الوفد ان القصور كانت صغيرة ومزخرفة بشكل مبالغ فيه، و"ليست مجرّدة من الأناقة، بل في حال يُرثى لها من الاهمال". وأضاف أن جزءا كبيرا من المباني يتكوّن من أكواخ متواضعة. كما أن مسكن الإمبراطور نفسه وقاعة المحاضرات الفخمة، بعد تجريدهما من التذهيب والألوان الصارخة التي طُليا بها، لا يتفوّقان إلا قليلاً على حظيرة مزارع إنجليزي!". لكنه أشاد بـ "المزهريات الرائعة المصنوعة من اليشب والعقيق و"أرقى أنواع الخزف الياباني"، وآلات القمار، والساعات، والآلات الموسيقية الرائعة".
في أربعينات القرن الثامن عشر في بريطانيا، بلغت موضة الطراز الصيني ذروتها. وبحلول التسعينات، غالبا ما كانت الأشياء الصينية تُعتبر مبتذلة، على الأقل بين الرجال ذوي الأذواق الكلاسيكية الجديدة. وكان الطراز الصيني، مثله مثل طراز الروكوكو الفرنسي أو العمارة القوطية الجديدة، يُعتبر متشاوفاً وزائفا.
لم يُظهِر الدبلوماسيون البريطانيون حماسا حقيقيا إلا لحدائق وأراضي القصر الإمبراطوري. وقال ماكارتني واصفا حدائق المنتجع الصيفي الإمبراطوري إنها "من أجمل مناظر الغابات في العالم" وأضاف: عند وصولنا إلى قمّة إحدى التلال، انفتح أمامنا فجأة مشهد يمتدّ لعشرين ميلاً، كان مشهدا غنيّا ومتنوّعا وجميلا وساميا لم ترَ عيناي مثله قط".
في صباح يوم 7 أكتوبر عام 1860، شقّت القوّات الفرنسية والبريطانية طريقها إلى قصر يوانمينغيوان. وعلى الرغم من أوامر القادة العسكريين، نهبَ الفرنسيون المجمّع، بينما سارع الإنغليز إلى عرض ما تبقى منه للبيع. وبعد عشرة أيّام، أحرقت القوات البريطانية المباني وما تبقّى من محتوياتها بالكامل. وكان لهذا التخريب سياق سياسي وعسكري تمثّل في انعدام انضباط الجيش الفرنسي ورغبة الانغليز في الانتقام من "المعاملة الوحشية" التي تلقّاها مجموعة من الرهائن على أيدي الصينيين.
كانت القوّات الفرنسية هي التي نفّذت معظم عمليات النهب. لكن القادة الفرنسيين نفوا رسميّا أيّ تورّط لهم، وألقوا باللوم في ذلك على عصابة من الصينيين الذين رافقوا الجيوش الأوروبية.
كان من بين من شهدوا تلك الأحداث اللورد إلجين الذي كان رجلا محافظا ومتشكّكا في الإمبريالية الجشعة، وكان أيضا من أتباع الشاعر كولريدج. وفي أكسفورد انجذب فكره إلى التكهّنات التجريدية الراقية، وقرأ أفلاطون وميلتون بالإضافة الى كولريدج. ومع ذلك، عندما واجه قصر يوانمينغيوان، أيقن أنه ليس القصر الذي وصفه كولريدج في قصيدته. فلم "يُغمض عينيه خوفا" ولم يشرب "حليب الجنّة". وبدلا من ذلك، شارك في إحراق المكان.
عندما تطوّرت الأمور إلى فكرة حرق القصر، رفض القادة الفرنسيون أيّ مشاركة. وقال البارون غروس: إننا نتحدّث باستمرار مع الصينيين عن "حضارتنا" وعن "الخيرية المسيحية"، وتدمير القصر سيكون عملاً همجيّاً ومنافقاً".
أما بالنسبة للجنود العاديين، سواءً البريطانيين أو الفرنسيين، فبمجرّد أن دخلوا بوّابات يوانمينغيوان، بدا وكأنهم في حلم. كانت تلك مملكة سحرية مليئة بكلّ الكنوز التي يمكن تخيّلها. ولم يكن الجنود قلقين مثل قادتهم من احتمال محاسبتهم، فاعترفوا بأفعالهم واستعانوا بخيالاتهم. قال أحدهم: لقد صُعقت وذُهلت ممّا رأيته، فجأة بدت لي ألف ليلة وليلة قابلة للتصديق تماما، كان كلّ شيء أشبه ما يكون بحكاية خرافية".
وقال آخر: شعرتُ كأنني علاء الدين ممتلئا بالدهشة في قصره المسحور المرصوف بالذهب والألماس. ولوصف ما رأيته سأحتاج إلى إذابة جميع الأحجار الثمينة المعروفة في ذهب سائل ورسم صورة بريشة من الماس تحتوي شعيراتها على جميع خيالات شاعر من الشرق".
وحدث الدمار النهائي في نوع من الهذيان. ركض الجنود من غرفة إلى أخرى باحثين عن الغنائم. كان هياجا ونهبا معربدا وكأن الجميع قد أصيبوا بجنون مؤقّت. وبدا الأمر كما لو أن الحرب التي تنبّأت بها "أصوات الأسلاف" في قصيدة كولريدج قد وصلت أخيرا، وأن الأوروبيين هم الشياطين الذين ينفّذونها.
كان الأوروبيون قد وعدوا بـ "بداية جديدة" للصين و"مستقبل مشرق من التقدّم والتجارة الحرّة". لكن كان لا بدّ أوّلا من تدمير العالم القديم، إذ لا سبيل لنشر "الحضارة" إلا من خلال أعمال همجية. وقال بعض الانغليز: كان تدمير قصر الإمبراطور أقوى دليل على قوّتنا المتفوّقة، فقد أسهم في دحض قناعة الصينيين السخيفة بسيادة مُلكهم على العالم. ومع هذا النصر، برز الأوروبيون أخيرا كحكّام للعالم بلا منازع".
worldhistory.org